تهافت أَحكام العلم في إِحكام الإيمان..حديث فيما قبل وما بعد العاصفة!
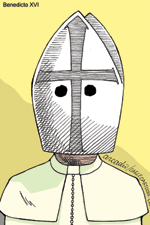
1 - لقاء هو بمثابة مقدمة:
يوم 28 كانون الثاني من العام 2004، نظمت الأكاديمية الكاثوليكية في ميونيخ لقاءً غير عادي بين الكاردينال جوزيف راتسنجر (البابا بندكت السادس عشر حالياً) والفيلسوف الألماني، الأستاذ الجامعي يورجن هبرماس حول «الأسس الأخلاقية للدولة الليبرالية». وقد صدرت حتي اليوم في نسخ وكتيبات عدة تحت عناوين مختلفة أهمها «ديالكتيك العلمنة-عن العقل والدين»، كما نشرت في قضايا الأكاديمية الكاثوليكية في بافاريا(1).
وقد اخترنا أن نبدأ هذه المساهمة القصيرة والمتواضعة حول محاضرة البابا الأخيرة في 12 سبتمبر 2006 بهذا الحوار غير المألوف الذي جري قبل هذا التاريخ بعامين. وسوف يلاحظ القارئ أننا نقصد بذلك أن المحاضرة البابوية الأخيرة التي أثارت ضجة عارمة بسبب ما ادعي فيها البابا من علاقة بين المسيحية والعقلانية والتنوير بين الإسلام والسيف لم تأتِ عرضاً مثل زلة أو هفوة. وهي لم ترد مفارقةً، بل عبرت، برأينا، عن منهج مثابر ودأب قديم للبابا. والمسائل التي أثارتها لا تحل لا بالمظاهرات، ولا بطلب اعتذار. فما قيل ليس شتيمة لغرض الإهانة والتسفيه لكي تحل باعتذار. والمظاهرةُ، إصراراً علي الاعتذار والتنصل، لا تقنع أحداً بتغيير رأيه، بل ربما تقنعه أن الخطأ في توقيت قوله وشكله، أو البوح به.
كان المفاجئ في هذا اللقاء المثير بين مفكر علماني وآخر لاهوتي بهذا الحجم، هو تقاربهما في طرح بعض الأفكار والهموم والإجابات عنها، في ظل هموم المجتمع الأوروبي المعاصرة.
أكد هبرماس أن مصدر نشوء الدولة الحديثة هو عملية العلمنة، وأن مصدر الدولة الديمقراطية بالحقوق الليبرالية هو فلسفة التنوير من القرنين السابع عشر والثامن عشر ... ولكنه أفسح مجالاً لقول يكاد يكون بديهياً أن كل هذا جري في إطار صورة للعالم أنتجتها الديانة التوحيدية، وأن بعض التنظيرات القرسطوية اللاهوتية، وبخاصة الإسبانية المتأخرة، ذات علاقة بتطور فكرة حقوق الإنسان.
ولا بأس بإفراد مفكر علماني هذا الدور للتراث الفكري اللاهوتي ولصورة العالم التوحيدية, فهذا تطور بالنسبة لرؤيته العقلانية الخالصة للعالم. وهو علي كل حال يؤكد في النهاية أن الدولة الليبرالية الديمقراطية لم تعد بحاجة إلي هذا التاريخ ,قد أصبحت قادرة أن تعيد إنتاج وتطوير ذاتها ومبادئها بغض النظر عن جذورها التاريخية. ولكنه يتساءل: هل بإمكان الدولة أن تجعل الأفراد يعون حقوقهم وحرياتهم في هذه الدولة وأن يأخذوها بجدية؟ وهل تستطيع الدولة أن تغرس فيهم الدافع للدفاع عن هذه الحقوق والحريات والاستعداد للتضحية في سبيل ذلك أيضاً؟
من وجهة نظر هبرماس طرأ خلل كبير في التوازن بين وسائل الاتصال الكبري بين البشر في الدولة الحديثة، فقد حاصرت قوي السوق والقوي البيروقراطية (الإدارية) التضامن الإنساني وهمشته، وهنالك حاجة للتأكيد من جديد علي مسألة دوافع البشر. و«يعترف» هبرماس في مساهمته الحوارية أن العلمانية السائدة في أوروبا لم تعد وحدها كافية للتعامل مع مسألة الدوافع، وبخاصة الدافع للتضحية دفاعاً عن الحريات. كما يري أنه من الضروري أن تنفتح هذه الثقافة وتتفاعل وتكون جاهزة للإصغاء والتعلم من التقاليد والأفكار الدينية دون أفكار مسبقة. وكما يبدو من قراءة هبرماس المتأخر الذي نجده في هذا اللقاء لم تعد «الوطنية الدستورية» كافية، ولم يعد «الفعل التواصلي في الحيز العام» يلبي الحاجة كدافع عند من كتب آلاف الصفحات في شرح هذه المقولات. ربما فهم أن التضامن المنتج للحيز العام لا يصدر عن توقيع عقد، ولا عن قرار عقلاني بدخول عقد اجتماعي، كما يفهم بعض الليبراليين خطأً نظرية العقد الاجتماعي كعملية نشوء المجتمع والدولة الحديثين، بدلاً من نظرية في المجتمع والدولة الحديثين. الفيلسوف الذي انتقد فلسفة ما بعد الحداثة كحالة من تحلل العقل وكمدرسة تدفع الغرب باتجاه اللاعقلانية، يجد نفسه في حالة بحث عن تضامنات، وعن صمغ لاصق للمجتمع، وعن دوافع للأفراد للدفاع عن الحقوق والحريات غير الحريات ذاتها. وهو يبتدع في هذا الحوار مقولة «المجتمع ما بعد العلماني»، أو «ما بعد العلمانية»، وذلك للتأسيس لحوار مطلوب دون أفكار مسبقة مع الثقافة الدينية والرؤية الدينية برأيه.
ويفرح الكاردينال بهذا اللقاء الفكري المفاجئ مع البروفيسور. فهو أصلا يتحرك نحوه من الاتجاه الآخر، وذلك لتأسيس لقاء مع العلمانية والعقلانية الأوروبية، وباختصار مع التنوير الأوروبي. إنه يعرض خدمات الكنيسة لحل أزمات المجتمع الأوروبي الحديث بجعلها أحد الأوصياء علي مسألة الهوية الأوروبية في عصر صراع الثقافات، وهو يحاول أن يلائمها مع متطلبات المجتمع الحديث بالتأكيد علي عقلانية عقيدتها... وهو، برأينا المتواضع، يدخل في رهان خاسر، فما يجذب الشباب والناس إلي الأصوليات البروتستانتية والإنجيلية علي أنواعها في الولايات المتحدة، وما قد يجذبهم للكاثوليكية ويملأ كنائسها الفارغة في أوروبا الغربية، ويملأها فعلاً في أمريكا اللاتينية وبعض دول أوروبا الشرقية، هو ليس عقلانية أرسطية من أي نوع.
في محاضرته في هذا اللقاء، يؤكد الكاردينال راتسنجر علي ضرورة مواجهة التحديات الكبري التي تعصف بالإنسانية، وأولها العولمة والتقدم التقني اللذان أنتجا قوة تدميرية غير مسبوقة. وهدف تدخل الدين التنويري هو ألا يتجاوز الناس حدود الحياة ذات المعني. هنا يلزم برأيه التأكيد علي أن القاعدة الأخلاقية والروحية للحقوق تتجاوز الحقوق ذاتها إلي العقل والروحانيات، والتوفيق بينهما، وإلي وضع أسس لواجبات الناس وليس فقط حقوقهم. ويقول راتسنجر في مساهمته في هذا اللقاء إن الإنسانية لا تحتاج إلي الحرب الكبري لكي تدرك المخاطر التدميرية، ف«الإرهاب» وحده كفيل بإيضاحها.
وهنا يثور الكاردينال بشكل خاص ضد ذلك «الإرهاب الإسلامي» الذي يحاول أن يبرر نفسه أخلاقياً بشرح علاقات الاضطهاد القائمة، أو دينياً بالاستناد إلي نصوص، ويتساءل مستنتجاً: «ألا يجب أن يوضع الدين تحت عباءة العقل، وأن توضع له حدود؟». العقل يدفع الدين إلي المساهمة في نشر ثقافة التسامح والحرية. يدلي الكاردينال إذاً بدلو الكنيسة في عقلنة الدين في صراعه ضد الأصوليات علي أنواعها، والإسلامية منها بشكل خاص، كمصدر للإرهاب.
والكاردينال بوضعه هذه المهمة نصب عينيه يخطئ إذ يتوجه شرقاً. فمهمته أن يتوجه غرباً ضد الأصوليات المسيحية العنيفة، وهي خصم الكنيسة الكاثوليكية الحالية الأساسي، وبدل أن يفعل ذلك يبدو كمن ينافسها في تشخيص الخصم الإسلامي.
جهد راتسنجر حقيقي، وهو يعبر عن نزعة قائمة في الكنيسة للمصالحة مع قيم العلم والتنوير قادها اليسوعيون في الماضي. وقد سبق أن طرح البابا يوحنا بولس الثاني العام 1996، وبتأثير من راتسنجر، مسألة اعتراف الكنيسة بنظرية النشوء والارتقاء (evolution) كأكثر من فرضية، ونشرت جريدة لوسيرفاتوري رومانو الناطقة بلسان الفاتيكان يوم 16 كانون الثاني 2006 نصاً من البروفيسور فيورينزي فاتشيني من جامعة بولونيا يتعامل بالتفصيل مع نظرية النشوء والارتقاء من لامارك إلي داروين. وتكرر ذلك في مجلة لاسفيليتا كاتوليكا في آب 2006، حيث كتب اليسوعي جوزيبي دي روزا مقالاً مشابهاً. والتوجه هو ليس ملاءَمة الدين لمتطلبات العلم الحديث فحسب، بل يتجاوز بشكل واضح سذاجة قصة الخلق كأنها عملية تأريخ تفصيلية، ويعتبرها قصة رمزية. ويتمسك في الوقت ذاته بأن الله ك«لوجوس»؛ هو خالق العالم، وهو بدايته ونهايته وغايته. ويدور هذا كله في سياق صراع داخل «الحضارة المسيحية الغربية» (بلغة صراع الحضارات طبعاً). إذ يتمرد في المرحلة نفسها إنجيليون أمريكيون علي مناهج التدريس في الولايات المتحدة لأنها تدرس نظريات النشوء والارتقاء، ويصرون علي النص الحرفي لسِفر التكوين كعملية خلق. جهد البابا الحالي لعقلنة الدين ضد الأصولية الإنجيلية قديم إذاً.
ولا يذَكِّر هذا الجهد بملاءمة النص القرآني تأويلاً، لا تفسيراً، مع مكتشفات العلم الحديث، وقد انتشرت أدبيات من هذا النوع تُؤوّل آيات قرآنية كأنها تتضمن ما اكتشفته نظريات علمية عن حركة الكواكب، وتكوّن الجنين في الرحم، ونظريات الوراثة، وغيرها. ولسبب ما يأتي تفسير الآية دائماً بأثر رجعي بعد أن تم الاكتشاف العلمي.
لم يكتشف أحد قانوناً علمياً بالطبع بفعل تفسير آية أو تأويلها. فهذا النوع من الأخذ بالنص عنوة وتأويله ليتناسب مع كل اكتشاف علمي، وإن كان يتعارض ظاهراً مع الأصولية المعارضة للتأويل، إلا أنه يتناسق في تركيبه الذهني والثقافي معها، وغالباً ما تنتشر هذه الأدبيات في الشارع مع انتشار الأصولية سياسياً كحالة من الشمولية النصية، وعلي وزن الإسلام هو الحل، يصبح الإسلام أيضاً هو العلم، ويتم الحط من شأن القرآن ليصبح نصاً شمولياً موسوعياً، بما في ذلك تنزيل قدره ليصبح نظرية علمية، أو تنبؤًا بعلم كأنه نوع من التنجيم. أما الجهد الكاثوليكي الجديد أعلاه، فخلافاً لأصولية الإنجيليين، لم يفسر حرفياً، كما أنه لم يؤوِّل علي هذا النحو التلفيقي المنتشر عند بعض الإسلاميين، بل حول التوراة إلي عبر رمزية، ومقولات إيمانية تتعايش مع الاكتشافات العلمية لكي يتجاوز التناقض بين النصوص الدينية وبعض العقائد المبنية عليها وبين اكتشافات العلم الحديث. مع هذا الجهد تنتقل الكنيسة من معارضة الاكتشافات في بعض الحالات إلي إفساح مجال لها بحصر نفسها ونصها في مجال آخر من فكر وعاطفة النفس البشرية، أما من يؤول النص ليجد فيه المكتشفات العلمية لا يفسح مجالا لأحد ويصر علي معادلة التناقض-عدم التناقض بين العلم والنص الدين... ولكن راتسنجر يدفع بالأمر خطوة أخري إلي الأمام، ليتجاوز، برأينا، ذلك الجهد للتعايش بين العلم والعقيدة الإيمانية إلي محاولة عقلنة العقيدة أو تقديس العقل ... وهو جهد فلسفي يخرج عن نطاق الدين.
ولا أعتقد أن عقلنة الدين فلسفياً هي الحل لمسألة الأصولية. وهو علي أي حال لا يستطيع لا من موقعه كبابا، ولا في خضم هذا الصراع أن يطرح تحدي العقلنة علي الإسلام. فهذا التحدي يطرحه فقط مثقفون علمانيون مسلمون ومسيحيون علي بعضهم البعض، ويتحاورون بشأنه حواراً ذا معني، دون اكتراث بحدود الطوائف والهويات. أما رجال الدين فيقبلون بالحد الأقصي أن يعقلن كل منهم عقيدته إذا شاء، وليترك تحدي عقلنة الدين الآخر لرجال الدين الآخر. ومن نافل القول إن الحوار بين رجال الديانات المختلفة في شأن كل دين لا ينتج علم ديانات مقارناً، ولا ينتج حواراً علي أساس عقلي وأخلاقي مشترك. والحوار هنا وهم لأنه لا يدور بين أفكار ومواقف علي أي نوع من القاعدة المشتركة، بل يدور بين مدعي تمثيل هويات وعقائد، فيؤكد الحدود بين هويات لا يتجاوزها.
يحاول البابا أن يقدم الكنيسة وعقيدتها أداة ناجعة في بناء هوية أوروبا فيما يسميه هو حوار الثقافات، وهو وجه آخر لصراع الحضارات. كما يحاول أن يقدمها كأداة عقلنة عريقة ومتزنة ومحافظة في وجه الأصوليات علي أنواعها.
تبدو المحافظة في أوروبا لأوروبا قمة التعقل والوسطية بين الأصوليات المحلية من جهة، والمهاجرين من الدول الإسلامية من جهة أخري، بين المحافظين الأمريكيين الجدد من جهة، والإسلام الأصولي من جهة أخري.
في هذا السياق يفترض أن نقرأ محاضرة البابا من أيلول 2006 التي أثارت كل هذا الجدل. والإسلام ليس عنصراً هامشياً فيها.
2 - الاجتهاد في التعبير،والاقتصاد في الخوف منه
عنون الفاتيكان محاضرة البابا بندكت السادس عشر في يوم 12 أيلول، كاجتماع مع ممثلي العلم وكمحاضرة للأب المقدس موضوعها: «الإيمان والعقل والجامعة- ذكريات وتأملات»، في إطار جولة كهنوتية قام بها إلي ميونيخ وريجنزبورج بين الأيام 9- 14 أيلول. وهي محاضرة كارثية بحكم منصبه لا بحكم ما أثارته من أفكار نمطية عن الإسلام. لا جديد في هذه الآراء المسبقة. الجديد في القائل، وفي المتلقي، وفي تقسيم أمريكي للعالم لم تشاور به أوروبا التي باتت قارة حدودية بفعل هذا التقسيم.
تعودت مؤخراً علي الاعتقاد أن معظم الكوارث البشرية، أي تلك التي تتم بمبادرة البشر، تقع في أيلول. وأنا أسلي النفس بأن أرجع ذلك لسبب بسيط؛ أن الناس تعود من العطلة باندفاع للعمل ... والمقصود هو اندفاع الناس الذين يعرفون العطل الصيفية ويمارسونها طقساً. ويتضمن الاندفاع عند الإنسانية جمعاء حماساً لارتكاب الحماقات أيضاً.
إضافة إلي أيلول ذاته، علينا أن نعتاد أن ممارسة رياضة حرية التعبير بإطلاق الأحكام المسيئة علي الديانات الأخري، لم تعد مجرد مظهر من مظاهر العلمانية الأوروبية التي تعمل في سياقها الحضاري والسياسي فتنزع القدسية والسحر عن قطاع اجتماعي بعد آخر، وتخصخص القرار في الشأن الديني، وتفصل عالم المقدس (الدين) عن عالم الدنيويات والمحسوسات والمرئيات، ولا ترتدع علما وفناً وأدباً، ولا تقف برهبة أمام مقدسات المسيحية. لم يعد كل هذا يفسرها لأنها باتت جزءاً من صراع عالمي بين هويات.
علي كل حال، لم تكن حرية التعبير في مسائل الدين دأب البابا في محاضرته. ولا نعتقد أنه بحاجة لمن يدافع عن حقه بالكلام.
المس بالدين الإسلامي ورموزه ونبيه، وهو إنسان في نظر الإسلام والمسلمين، وبالتالي غير مقدس، بات عند صناع الرأي العام من المسلمين ليس مساً بالمقدس فحسب، بل يتجاوز المس بالمقدس إلي الحط من شأن المسلمين وحضارتهم وهويتهم، ويتحول إلي داعٍ للتظاهر والحرق والتكسير عند جمهور يبدو مفرط الحساسية والانفعال من قضايا هوية وثقافة ليست كلها من صنعه ... وكأنه يؤكد مقولة اليمين الأكاديمي في الولايات المتحدة وبشكل متزايد في الغرب، أن عالمنا في حالة صراع، هو فعلاً صراع حضارات في جوهره. فالاحتجاج علي رسوم الكاريكاتير وحتي علي جمل البابا ليس نضالاً ضد حالة استعمارية، بل هو تعبير صادق عن غياب مشروع نضالي تحرري دفاعاً عن المصالح الاجتماعية والوطنية وحالة تقصر الحقوق علي الحقوق الثقافية أمام الغرب ... «الناس تأتي علي تعبيرها بدل أن تأتي علي مصالحها»، كما قال والتر بنيامين عن حالة أخري في سياق آخر استبدلت مصالح العمال بالتعبير عن هويتهم.
باتت هذه الحالة تتأثر بأنماط التعبير من الأدب والفن والرسم والكلام والتمثيل، وتأخذ بجدية كلاماً من نوع اقتباس المحاضر نصاً من القرن الرابع عشر. وكأن البابا البروفيسور ومصدره غير المقرظ وغير العلمي عن الإسلام يحددان جوهر الإسلام. لا يمكن أن تعتبر هذه الحالة من الانفعال حالة ارتياح في الهوية وثقة بالنفس، نقول هذا لنجتنب تفسيراً تآمرياً تستغل بموجبه نخب سياسية ودينية مشاعر الناس الحادة حول مسائل الهوية بدلاً عن مسائل المصالح من أجل تحقيق وممارسة قيادتها للرأي العام وما يسمي «تحريك الشارع». ولا شك أنه إذا كان التيار الديني سياسياً، فإنه يستفيد سياسياً من اعتبار الناس المس بهويتهم الدينية دافعاً أولاً للتظاهر والاحتجاج.
ومن أخطر مظاهر حماقة المس بالدين والردود عليها أن تمثيل الحيز العام ينتقل إلي رجال الدين، و«الحوار بين الديانات» ينفذ عملياً كحوار بين رجال دين متعددي الأمزجة ومتفاوتي الثقافة، إذ ينصبون من قبل الاستوديوهات ممثلين للناس أو للديانات. ورجل الدين لا يمثل الدين، فالدين ليس بحاجة إلي تمثيل، وحاشا لله أن يحتاج إلي من يمثله، ويصغر حتي الأنبياء ناقلو رسالته عن تمثيله. وهو لا يمثل الناس أيضاً. فمن زاوية نظر الدين قد يوقعه تمثيل الناس والرغبة في نيل ثقتهم في منزلقات ومعاصٍ تصل حد الكفر. أما من زاوية المفهوم العلماني للتمثيل فلم ينتخبه أو ينتدبه أحد. ولكن كلاماً من نوع كلام البابا يحول المشهد الإعلامي، وهو مشهد التعددية السياسية الوحيد في البلدان العربية حالياً، إلي حوار أو صراع بين رجال دين من ديانتين مختلفتين ... يفترض في أفضل الحالات أن يتوسطوا بين العقيدة والمؤمنين علي درجاتهم، وأن يقودوا شعائر الصلاة وغيرها. القيادة منتخبة أم غير منتخبة هي قيادة لمجموعات من الناس، وقد تكون هذه المجموعات عبارة عن طوائف، أو تنظيمات أو تكون قيادة للشعب. أما «الروح» فليست بحاجة إلي قيادة من هذا النوع. و«القيادة الروحية» هي مجرد تعبير سياسي بائس، وأداة غير مفحوصة المعني ولا المنشأ ولا الهدف، يستخدمها من ينصبون أنفسهم قيادة علي الناس، وناطقين باسمهم، وليس هذا دورهم.
وإذا وجد بينهم مفكر يتجاوز المهمة والدور إلي التفكير بالنصوص والتأمل بها، فهو لا يفعل ذلك كشخص مقدس أو تحيطه هالة من القدسية، بل كإنسان مثقف. ولا يهم في ذلك إن كان لقبه كاهناً أم شيخاً، أم فقيهاً أم حَبراً أعظم. فهو في هذه الحالات، بل في أفضل الحالات، إنسان يجتهد. وبالمناسبة، المثقف العلماني بحكم تعريفه يجتهد ليستحق تسمية مثقف. واجتهاده هو القاعدة لكي يعتبر مفكراً غير محكوم بنص مقدس ديني أو علماني، أما رجل الدين، فحتي حين يجتهد إنما يجتهد كاستثناء يؤكد القاعدة، وهي النص المقدس. ويبقي الاجتهادان، المتحرر وغير المتحرر من النص، اجتهادين إنسانيين منزوعي القداسة، ولا ينبغي أن يقدسا حتي من زاوية نظر التدين.
الاستنتاج الأول: لا قداسة في اجتهاد قداسة البابا، ولا قداسة في أي رد عليه، لا ردنا ولا غيره.
ليس الإسلام موضوع محاضرة البابا أعلاه، هذا صحيح في الظاهر فقط. وقد بينا ذلك أعلاه في طرح «الإرهاب الإسلامي» كهم يؤرقه منذ فترة. ولكن حتي لو كان صحيحاً ظاهراً وباطناً، فإن هذا لا يجعلها ولا يجعل اقتباساته عن الإسلام من نص محرر من القرن الرابع عشر أقل خطورة. فالفكرة الواردة عن «الإسلام» في النص هي مجرد أداة إيضاح للعلاقة غير المرغوبة برأيه بين العقل والإيمان في العقيدة الدينية ذاتها. وإذا كان رأي البابا بالإسلام هو ما يرد من ريشة الملك البيزنطي منويل الثاني أم لم يكن، يتم في المحاضرة توسل هذا «الإسلام» كلون معاكس في الخلفية لإيضاح اللون المرغوب بابوياً للعقيدة المسيحية، مثل كونتراست. فالمرفوض المكروه يجلب لإيضاح المرغوب. علي ضوء ذلك، يصبح السؤال «هل المرغوب هو موضوع المحاضرة أم المكروه؟»، «هل المسيحية هي موضوع المحاضرة أم الإسلام؟» سؤالاً غير مهم.
البابا أستاذ جامعي يستخدم تعميماً بهذه الشحة من المصادر والفقر في المرجعيات من منويل الثاني حتي ابن حزم، وحتي لو صح ما قاله عن الإسلام كحالة لتوسع عقيدة بقوة السيف، وبالقوة بدلاً من الحجة... فإن هذا برأيه ما لا يجب أن يكون.
الغريب أن البابا لم يجلب أمثلة لما يجب ألا يكون من سياق تاريخي معروف له، ولا يعاني بشأنه من شحة المصادر وقلة التبحر. فهو مطلع علي الحملات الصليبية ودور الباباوات في التعبئة لها، وعلي عملية تنصير شعوب أمريكا الجنوبية بحد السيف والبارود، وعلي مرافقة المبشرين الاستعمار في أفريقيا، وإن كان بوسعه أن يدين ويستنكر ثم يفتخر في الوقت ذاته بموقف رهبانيات مثل اليسوعيين في حينه ضد قوات ال«كونكويستا» ومذابحهم. كانت لديه فرصة أن يستشهد بهم وينتقد تخلي الفاتيكان عنهم في تلك المرحلة لصالح علاقتها بالملوك في أسبانيا والبرتغال؟ كانت لديه فرصة لنقد المؤسسة الكنسية وعلاقتها بالملوك وإدراكها البراغماتي لمعني القوة في السياسة وتحالفاتها مع سياسات القوة وخوضها الحروب، مثبتاً علي الأقل وجود تيار آخر في المسيحية يمكنه المفاخرة به في بعض مواقفه علي الأقل، مثل اليسوعيين والفرنسيسكان، أقرب إلي ما يدعيه هو اليوم عن الكنيسة ككل. كان لديه ما يفاخر به أيضاً حتي لو أدان محاكم التفتيش التي استخدمت من قبل الفاتيكان لفرض «سنته» و«طريقه القويم»، ومكونات عقيدته سالمة غير منقوصة بالقوة ضد كافة أنواع الفرق الألفية والهراطقة وغيرها، ناهيك عن إعمال السيف والقتل لحل قضايا مثل وحدانية الطبيعة الإلهية، أو الطبيعة المزدوجة للمسيح. وكان بإمكانه أن يعددها ويعدد الثورات المسيحية عليها. كان بإمكانه أن ينتقد نزعات مسيحية لاستخدام العنف لفض الخلافات العقائدية، مثل الحروب الدينية في أوروبا ذاتها، وأن يفتخر بتقاليد مسيحية أخري مثل دور الكنيسة الكاثوليكية بين فلاحي أمريكا اللاتينية وفي ريفها. ولكنه اختار أن ينحو منحي آخر، أن يثبت جوهراً مفترضا للمسيحية مقابل جوهر مفترض للإسلام في قضايا العقل والمنطق والعنف. ولذلك يتجه إلي نص عن الإسلام للبحث عن مثلٍ لنشر الدين بحد السيف، وذلك من ريشة ملك بلد يكتب ويحارب وبلده يتعرض لحصار دولة إسلامية، ويتبع لها أحياناً بشروط مذلة.
وقد اختار هذا النص ليقول: إن دور العقل في الإيمان هو جوهر المسيحية، وهو يقصد المسيحية الكاثوليكية تحديداً، وأنّ للعقل دوراً في إثبات حقائق الإيمان، وأن العقل ليس حكراً علي العلمانيين، وأن الله في المسيحية، خلافاً للإسلام، ليس محرراً من أحكام الله ذاته ألا وهي العقل، وأن ما يمكننا من التفكير بالشئون الإلهية وتذهنها، هو هذا العقل الكوني. والحقيقة أن لا هذه جوهر المسيحية (فلا جوهر للمسيحية ولا للإسلام) ولا هي علامتها الفارقة، ولا هي غريبة عن الإسلام. فقد ميزت مثل هذه النقاشات «محنة خلق القرآن» ونقاشات المعتزلة في عهد المأمون، والنقاش بين الغزالي وابن رشد... ولكن لندع ذلك جانباً حالياً، فقد اختار البابا التعميم الأسهل. والتعميم الانتقائي والسهل يميز رجال الدين بحكم موقعهم في كل مكان وفي كل دين كممثلين لأفضل عقيدة ممكنة بين العقائد.
ما يهمنا الآن هو أن البابا كمحاضر جعل مسألة عقيدية، مثل حضور أو غياب إعمال العقل في قضايا الإيمان، وليس حالة اجتماعية أو تاريخية، المقدمة والسبب من وراء استخدام القوة بدل الإقناع في عملية نشر العقيدة. وهذا خطأ. إذ لا تشتق السلوكيات والسياسات، بما فيها العنف السياسي، بهذا الشكل الفج من النصوص والأفكار حتي لو كان حكمه عليها صحيحاً. وهو غير صحيح. فقد تستخدم النصوص في تبرير الأفعال، وقد تشكل مصدراً تربوياً، وذلك بحسب من يربي ولأي هدف. فإذا استخدم سفر يشوع كحكاية مما قبل التاريخ, شيء، وإذا استخدمت لتبرير المذابح الجماعية بأمر إلهي, شيء آخر. وفي الحالتين لا يصح اشتقاق الإرهاب الصهيوني في فلسطين حالياً من عنف التوراة مباشرة وقصصها دون سكان فلسطين الأصليين في حينه. هذه قفزة فوق أي تفكير علمي بمحددات الفعل السياسي الاجتماعية والأيديولوجية والتاريخية.
تنتفض العلوم الاجتماعية علي تبسيطية واختزالية نظريات كاملة وضعت في تفسير سلوك الناس بثقافتهم، انطلاقاً من حضارتهم، التي ولدوا ونشأوا فيها، كما كانت صفات العِرق المفترضة تفسر طبيعة سلوك البشر وعاداتهم وقيمهم في الفكر العنصري العرقي. ولكن البابا لا يكتفي بتعيين الثقافة، بل يعتبر ضمناً أن النص الديني يكفي لشرح ظاهرة مركبة مثل العنف الديني. وهذا أسوأ من تفكير هنتنجتون في صراع الحضارات، ويقترب من أسلوب تفكير برنارد لويس الذي يعتمد عليه هنتنجتون بوضعه النص الديني في المركز كأنه قلب الحضارة النابض. ولم يكتفِ الحبر الأعظم بهذا الخطأ، فاختار نصاً بيزنطياً عن الإسلام لتوضيح ذلك. وهذا خطأ أفدح. أدي هذا إلي صدور حكم متهافت علي الإسلام، لا أساس عقلياً ولا قرينة تاريخية له، وإذا توفرت فهي تتوفر عن الإسلام والمسيحية علي حد سواء. فمن شن الحروب هو ليس العقائد بل القادة والناس، المؤسسات والدول، أي ليس العقائد بل المؤمنون بها، أو المستخدمون لها إذا شاء القارئ، المحكومون بظروف سياسية واجتماعية محددة، ومن هنا سميت غزواً حيناً، (علي نمط غزوة أحد وغزوة بدر)، وحرباً حيناً، وفتوحات أحياناً، وحملات لنشر كلمة الله عند «فتح» أمريكا، وحروباً صليبية أحياناً.
ربما يجبر الرد علي هذه الأقوال والتعميمات المقتبسة بالعنف والحرق والاحتجاج وبالمسيرات البابا وغيره علي التأسف علنا، كنوع من اللياقة السياسية. ولكننا نخشي أن هذا يتم لتأكيد سريرتهم، تقيتهم إذا شاء القارئ، الراسخة قناعةً أن هذا العنف المطالب بالاعتذار وإلا ... ما هو إلا تأكيد للتعميم وتثبيت لصحته. فبدل مقارعة الحجة بالحجة استخدم الضغط السياسي لا للاعتراف بالخطأ، بل للاعتذار. وهو نوع من الضغط المادي لا المحاججة العقلية. وعن مثل هذا الكلام يصح أن يقال إن فعل البابا ليس مقولة علمية تحتاج إلي تفنيد، بل هو موقف سياسي، وموقف علني يصدر عن منصب كهذا هو فعل سياسي أيضاً، وعليه أن يعتذر كتراجع سياسي، ولا بأس أن يتراجع كفعل سياسي أيضاً، ثم نتناقش.
الاستنتاج الثاني: ما طرحه البابا يدخل في باب الأيديولوجية لا الحجة العلمية. والرد عليه لا يقل أيديولوجية وسياسة. أما الرد الشعبي عليه، أعنيفاً كان أم غير عنيف، فلا يقنع أحداً، وقد يدفع إلي التراجع والاعتذار، ولكنه يضعف أيضاً الدعاية الأيديولوجية المعاكسة عن طبيعة الثقافة المحتجة علي التشهير بها.
كان هذان الاستنتاجان مقدمة إضافية لمحاولة مناقشة المحاضرة، ليس انطلاقاً من الاقتباس القديم الذي أثار غضب الناس، بمن فيهم كاتب هذه السطور، بل انطلاق من ادعاءاتها التي جاء الاقتباس ليوضحها مثل حكاية تروي من كليلة ودمنة.
3 - نقتنع عقلاً، أم نُسَلِّم إيمانا؟
يبدأ البابا محاضرته الجامعية بالتعبير عن حنين إلي خصوصية الجامعة التي قوضتها الاختصاصات الجامعية؛ أي إلي العقلانية الواحدة التي تجمع بينها وتشكل أساساً للحوار بين الاختصاصات. إنه يدافع في الواقع عن الفلسفة واللاهوت كخاضعين للعقل العلمي نفسه الذي يحكم عمل الاختصاصات. وهو يعتبر الحياة الجامعية تجربة حياتية للاستخدام الصحيح للعقل بغض النظر عن الاختصاص. ويشكل قسم اللاهوت برأيه جزءاً من هذا التكوين لأنه يعني ببحث «عقلانية الإيمان»، حتي لو لم يتشارك في هذا الإيمان جميع المعنيين بالبحث. كل ذلك في مقدمة تذكَّر فيها حياته الجامعية كمدرس في جامعة بون العام 1959. إنه يؤكد علي «استخدام العقل في إطار التقاليد المسيحية في طرح مسألة وجود الله نفسه في وجه الريبية التشكيكية». ولا شك أنه كأستاذ جامعي منذ الستينيات ما زال واقعاً تحت تأثير النقاشات التي ترفض اللاهوت كعلم جامعي.
هنا بالتحديد، أي عندما يبدأ بالإشارة إلي عقلانية الدين التي تبرر اللاهوت كعلم، يتذكر البابا حواراً قرأه مؤخراً في كتاب حرره البروفيسور ثيودور خوري من جامعة مونستر. وقد دار الحوار المفترض بين ملك بيزنطي ومثقف فارسي. ويقول البابا إنه من الواضح أن الملك كتب هذا الحوار كله عن حقيقة الإسلام والمسيحية بين الأعوام 1394 و1402 أثناء حصار القسطنطينية، ولا وجود في الواقع لهذا الفارسي. ولا يرغب البابا في تناول النص كله حول ثلاثة أنظمة أو «قوانين الحياة» كما تسمي في هذا النص الكتب الثلاثة: العهد القديم (التوراة)، والعهد الجديد (الإنجيل)، والقرآن، وإنما يؤكد أنه يريد التطرق إلي نقطة هامشية في النص ذاته. ويستدرك البابا قبل أن يقتبس أنه لا بد من أن الملك كان علي علم بالسورة القرآنية «لا إكراه في الدين». البابا وليس الملك يقول ذلك. وهو، أي البابا، يقتبس الخبراء الذين يقولون إن هذه السورة من فترة مبكرة كان فيها محمد ضعيفاً وعاجزاً (يقصد مكية، وهي في الواقع سورة مدنية متأخرة... إنه لأمر مؤسف أن يخطئ البابا هكذا في الاعتماد علي المصادر). وطبيعي، يقول الحبر الأعظم، أن الملك كان علي علم ب«الفرائض التي صدرت لاحقاً وسجلها القرآن والخاصة بالجهاد المقدس». ليس هكذا يقدم المحاضر لنص لا يوافق عليه. ثم ينتقل إلي اقتباسه الذي أثار الناس: يخاطب الملك محاوره «بفجاجة مذهلة» (مقتبس من محاضرة البابا) حول القضية المركزية التي تخص العلاقة بين الدين والعقل والعنف بشكل عام: «أرني فقط ما الجديد الذي جلبه محمد. سوف تجد فقط أموراً شريرة وغير إنسانية، مثل فريضة نشر الإيمان بالسيف». ثم يقول الملك: «لا يتم إرضاء الله بالدم. والسلوك غير العقلاني يناقض طبيعة الله... والعنف يناقض طبيعة الله وطبيعة الروح. يولد الإيمان من الروح وليس من الجسم، وكل من يرغب في قيادة أحدهم إلي الإيمان يلزمه قدرة علي الكلام والمحاججة العقلية دون عنف وتهديد... من أجل إقناع روح عاقلة لا يحتاج المرء إلي ذراع قوية أو أسلحة من أي نوع، ولا إلي أي أداة لتهديد شخص بالموت». ولا شك أن ما قاله الملك عن الإسلام ينطبق عليه في لحظة ضعفه. فليس هكذا تكلم الأباطرة الرومان عن المسيحية في مرحلة قوتهم، ولم تتحول المسيحية صدفة إلي ديانة رسمية في الإمبراطورية الشرقية، ثم في دول أوروبا... لقد تحالفت المسيحية في حينه مع القوة.
وبرأي البابا، فإن الجملة الأساسية في النص البيزنطي المحرر هي: «أن السلوك غير العقلاني مناقض لطبيعة الله». ويضيف المحرر ثيودور خوري ملاحظة يوافق عليها البابا، أن هذه الفكرة مفروغ منها بالنسبة للملك بصفته بيزنطياً متأثراً بالفلسفة اليونانية، أما بالنسبة للمسلم فالله «ترانسندنتالي»، أي ينتمي إلي العالم الآخر بشكل مطلق، إنه منفصل كلياً عن عالمنا، ولا يخضع لأي من مفاهيمنا، بما فيها تلك العقلانية. لماذا قرر المحرر والمحاضر أن مثقفاً إسلامياً من القرن الرابع عشر لم يتأثر ولم يتفاعل مع الفلسفة اليونانية؟ هذا لغز لا أستطيع له حلاً، وبخاصة أننا نعرف دور الفلسفة اليونانية في تشكيل الحضارة الإسلامية، ودور الترجمات الفلسفية العربية عنها في نشوء فلسفة القرون الوسطي والأديرة الأوروبية حتي النهضة. وهنا يستشهد المحرر بابن حزم بواسطة المستشرق الفرنسي أرنالديز. وتصل آخرية الله عند ابن حزم حسب أرنالديز حد القول إن الله لا يخضع حتي لكلامه ذاته، ولا شيء يجبره علي كشف الحقيقة لنا ... ونفس النبرة نقول: لا شيء يجبر البابا أن يكشف لنا لماذا أصبح ابن حزم الظاهري المرجع الأول والأخير عن عقلانية الله في الإسلام.
يدعي البابا أن لقاء المسيحية مع الفلسفة اليونانية لم يأتِ صدفة، إذ أن الإنجيل يصل قمته في «في البدء كان الكلمة -لوجوس، وكان الكلمة عند الله، وكان الكلمة الله» في يوحنا الإنجيلي. و«لوجوس» تعني عقلاً وكلمة في الوقت ذاته. ومن الرمزية بمكان في نظر البابا أن يجد بولس الرسول طرق آسيا مغلقة في وجهه، ويري مناماً يدعوه فيه رجل مقدوني إلي القدوم إلي مقدونيا لمساعدة أهلها.
أما من أين للمحرر والبابا هذا الجزم بأن طبيعة الله قد تكون غير عقلانية في الإسلام؟ من ابن حزم وحده؟ هذا لغز حقيقي آخر بالنسبة لباحث يريد أن يفهم محاضرة البابا. «اللاعقلانية» التي تميز سلوك الآلهة اليونانية هي اقتداؤها بالبشر، في تنظيرات الفلسفة اليونانية عند سقراط تحديداً في نقدها، والتقديم نحو التوحيد عند أفلوطين (A1 ) والرواقيين. فكيف أصبح الاقتداء بعقل البشر هو عقلانية الله عند من يريد توظيف الفلسفة اليونانية؟ لن أجيب عن هذا السؤال البسيط. كما أفترض أن البابا يلاحظ دون جهد لاعقلانية ومزاجية عنيفة وشهوة وغيره وغيره في كلام «يهوا» التوراتي وسلوكه، إله إبراهيم وإسحق وموسي وداود وسليمان، حتي مقارنة بسلوك البشر وعقلانيتهم... وسلوكه غالباً ما يحير أنبياءه في التوراة ذاتها. فهو يغضب ويفرح وينتقم ويحب ويكره ويأمر بالقتل الفردي والجماعي. ويصر بعض الفلاسفة علي لاعقلانية جوهرية في الديانات التوحيدية، وبخاصة إزاء فكرة حرية الاختيار وقدرة الله غير المتناهية، وفي خلق الله الناس ليعبدوه في الديانات كافة، وفي فكرة العقاب في الجحيم، وفكرة أن الله خلق الناس ليعبدوه وخلق حرية ألا يعبدوه ثم خلق عذابهم في الجحيم. وفكرة التعذيب بذاتها مخيفة أن تنسب إلي الله، ومتناقضة مع الرحمة... ولكنها لم تكن أفكاراً عذبت وحيرت فقهاء المسلمين والمتكلمين والأشاعرة والمعتزلة في محاولة عقلنتها فحسب، بل عذبت الفلسفة المسيحية القرسطوية برمتها وعذبت قراءها.
ليست هنالك صعوبة بإثبات إرث فلسفي كامل من الفلسفة اليونانية يتناقش مع المسيحية واليهودية بما في ذلك صفات الخالق فيها باعتبارها غير عقلانية. ونحن لا نجد ذلك بالطبع في الفلسفة القرسطوية ولا حتي في بدايات الفلسفة الحديثة. فبدايات الفلسفة الحديثة تحاول عقلنة المسيحية، كما يحاول البابا حالياً بتأخر خمسة قرون. وليس صدفة أن يبدأ ديكارت التحول الفلسفي الشكِّي العقلاني بإثبات وجود الله عقلياً دون الحاجة لإيمان، وعند كانط وضع الدين في حدود العقل لكي يفهم من منطلق وظيفته، وعند هيجل المسيحية هي تمظهر عقلي تطوره الفلسفة الغربية. ونقد الفلسفة الأوربية الحديثة للدين يقف علي قاعدة الدين المسيحي نفسها، وبخاصة في وضع نظريات التاريخ وفلسفته كتقدم نحو خلاص. بهذا المعني، فإن منظومات الفلسفات الغربية كلها أنصاف ثيولوجيا مسيحية كما يقول نيتشه. ونحن نؤكد أن هذا لا ينطبق علي النقد التنويري للدين، ولا علي نقد نيتشه ذاته، كما لا ينطبق علي المناهج الفلسفية التي لم تشكل منظومات فلسفية مغلقة كما سوف نري.
ويوفر كارل لوفيث علينا جهداً كبيراً، إذ يستشهد في مقاله الرائع: «المسيحية والتاريخ والفلسفة» بحوار فلسفي يوناني مبكر ينسف مقولة البابا المتأخرة، لأن الحوار الذي يورده هو ابن العصر الذي تم فيه بحسب البابا التزاوج بين التوراة والفلسفة «التنويرية» اليونانية. والنقاش بين رجل دين مسيحي يوناني، أوريجينس، وفيلسوف يوناني كيلسوس(2). ويؤكد فيه الثاني التناقض الأصلي الواضح، أي الذي لم تجسره الفلسفات الغربية اللاحقة المذكورة، بين الفلسفة اليونانية والمسيحية. يفند فيه الفيلسوف عقلانية المسيحية واليهودية، ويؤكد غرابتها عن سوية التفكير الهيليني، ويؤكد تناقض تصوراتها لله والإنسان والعالم مع العقل «لوجوس». وهي الادعاءات نفسها التي يأتي نيتشه عليها لاحقاً في كتابه أنتي كريست، أو اللامسيح. فهو يعتبر أفكاراً من نوع أن الله خلق العالم في خدمة البشر، والبشر لعبادة الله، أفكاراً غير مفهومة ولا معني لها. وهو يستفظع فكرة أن الشمس والقمر والنجوم والأرض خلقت لخدمة الإنسان. وفكرة خلق الله العالم اعتباطياً تجنب المؤمنين بها ضرورة فهم منطق الطبيعة الداخلي. كما يستغرب معني تغير طبيعة البشر عبر الثواب والعقاب والاعتراف والتكفير عن الذنوب، فهذا يناقض كونها طبيعة. ولا يفهم معني أن يبدأ الله بعد تجسده بعدد قليل من المؤمنين، وأن يعاني ويصلب ويتعذب... هذا عدا نقده أخلاقيات تقديس التعاسة والفقر والضعف والمرض في الطوباويات المسيحية وعدم البحث عن الأصحاء عقلاً وجسداً كنموذج، وهي أخلاقيات وجماليات مناقضة لجماليات الثقافة الهيلينية والفلسفة اليونانية.
وواضح أن فلسفة النهضة شكلت فيما بعد فعلاً مسيحياً باتجاه استعادة الفكر والأخلاق والجماليات اليونانية إلي المسيحية... ولم يكن هذا الجهد خلواً من المواجهات مع المؤسسة الكنسية، كما لم يجرِ بمعزل عن احتضان المؤسسة الكنسية والأديرة لها، خلافاً لما ينتشر من آراء مسبقة عن الكنيسة كمعارض للعلم.
ولا شك أن الإسلام يعرض الله كذات منطقية عقلانية، ولكنه يعود ويتجنب تحديد الله بحدود العقل البشري، ما يميز الإيمان الديني عن الفلسفة. الإيمان هو باللغات السامية وغير السامية تصديق. وما زال الفعل ذاته «هئمين» يعني بالعبرية صدّق كما يعني آمن، تماماً مثل (glauben) و(believe) بالألمانية والإنجليزية. ويستخدم للدلالة علي المعنيين. علي المؤمن أن يصدِّق أولاً ما هو فوق العقل - أو تحته، حسب وجهة النظر- لكي يؤمن، أو أن يؤمن لكي يصدق. ليس عليه أن يقتنع علمياً، ولا عقلانياً. لا دور هنا للعقل، لا في الإسلام، ولا في المسيحية، ولا في اليهودية. ولو كان قرار الإيمان قراراً عقليا بناء علي منطق ما، لما كان قراراً حراً. وحرية الإيمان هي جوهره الديني والأخلاقي. وهي التي تفصله وتفضله، بنظر الدين، علي عدم الإيمان. وهي التي تجعل الفرد مسئولا أمام الله عن عدم إيمانه.
لا يخلو دين من مسلمات إيمانية، ومنها تنطلق المحاكمات العقلية المنطقية. وحتي لو اشتقت الاستنتاجات عقلياً بالاستدلال، فإن هذه الاستنتاجات لا تعني الكثير لغير المؤمن الذي لا يقبل المسلمات التي اشتقت منها. أما بالنسبة لسلوك الله ذاته، فلا أدري عن حالة نبوة ابتعدت عن صنمية الله وتعددية الآلهة إلا ووصفت هذا السلوك بلغة مفهومة عقلياً، وإلا وحاولت شرحه إما بأمر أخلاقي أو بمنطق عقلي، وإما برحمة إله رحيم أو بعقل يبرر غاية هذا السلوك ويقدر علي شرحها. وفي بداية الديانات التوحيدية كافة إله غاضب علي ما كان قبله من عبادات، وفي بداية الديانات كافة إله داعٍ وناهٍ بفرائض ومحرمات تميزه عن دين آخر، ولا معني عقلياً لها إلا في تفسيرها من قبل المؤمنين، إما كرموز ومؤشرات لإرادة الله لا يفهمها المؤمنون بل يفهمون غايتها، وإما كطقوس وشعائر لإعادة تمثيل وتمثل تجربة من الولادة والعمادة والبلوغ وفطير الفصح ونزول التوراة والعرش والعشاء السري والصلب والقيامة والتضحية بالخراف بدل ابن إيراهيم والتطهر بالماء وحتي شعائر الموت والجنازة.
في كل دين إله يحرم ويحلل وينتج أخلاقاً، أو يضفي طابع قدسية علي الأخلاق باعتبارها فرائض. وقد يحرم عادات بات العقل لا يقبلها في مرحلة تاريخية محددة. ولكن لن ينجح العقل بشرح تحريم الله للحوم بعينها، واختيار الصيام في شهر بعينه، وأوقات بعينها للصلاة، وإذ يحاول البعض شرح ذلك فإنهم يجدون أنفسهم يحولون الله إلي خبير تغذية أو «ريجيم» أو طب، ويجهدون لإثبات ذلك. كل دين يتواصل مع ديانات جاءت قبله عبر تقديس أماكن وتكرار طقوس ومنحها تفسيراً آخر، وتحليل وتحريم للتواصل مع ما كان، والتميز عنه كدين منفصل بالحفاظ علي بعض العادات التعبدية مثلاً، ولكن تحريم بعض ما كان حلالاً، وتحليل بعض ما كان حراماً. لا بد من تحريم وتحليل يميز الدين، وفرائض تميزه، لا تفسير منطقياً لها. ربما يؤدي الفرائض من يفهمها بهذا الشكل، ولكن سوف يصعب عليه أن يؤديها بخشوع.
تجد الكنيسة ما تثبت به ضرورة أن يمر الطقس الكنسي بهذا الشكل أو بذاك، وأن يرتدي الكاهن هذا الزي بالتحديد، وأن ما يبدو مثل شعوذة يحمل معاني عميقة أو له تفسير تاريخي علي الأقل. والباحث المثقف والمؤمن في الوقت ذاته يريح نفسه فيدعي أن هذه تقاليد، ثم يعمِل العقل في إثبات فائدة احترام التقاليد للحفاظ علي سلامة المجتمع ومنعاً للفوضي وحفاظاً علي المؤسسات الاجتماعية والمؤسسة الكنسية. ولكن هذا النوع من الإثباتات والأدلة هو محاولة لإثبات وظيفة الطقس الكنسي وليس صحته أو خطئه.
ونحن نفترض أن هنالك من يقتنع بشرح كهذا لوظيفة المحرمات والمحللات والفرائض والوصايا وضرورتها إذا وافق علي الهدف. ولكن لا بد من التأكيد أن وظيفة العقل ذاته في هذه الحالة هي أداتية تماماً. لا هو جوهر ولا هو مصدر، ولا هو هدف أو معني ... ليس لوجوس بالمعني اليوناني أو (vernunft) بلغة الفلسفة الألمانية الني يستخدمها البابا. ويمكن أن يكون دافع شخص إلي تأدية الفرائض الدينية هو حساب عقلي لوظيفتها الاجتماعية حتي دون إيمان. وحتي في هذه الحالة لا يصح عبر هذا الشرح أن نقول إننا حسمنا بالعقل في مسألة الإيمان، بل في مسألة ضرورة تأدية الفرائض أم عدم ضرورتها. ولكن الدين بما فيه المؤسسة الكنسية يقوم علي مؤمنين ورعين يؤدون كل هذه الفرائض والطقوس بخشوع، أو يؤدونها كعادة وتقليد مسلم به، أو كنمط حياة متوارث، أو كهوية وانتماء، ولا يعملون فيها الفكر كثيراً، حتي إذا كانوا يعيدون إنتاج الجماعة البشرية العينية من خلال هذا التعبد دون أن يدروا.
4 - محبة الله ليست محبة العقل، ليست تحليلية:
ويعود المحاضر إلي معاصرة التوراة للحضارة الهيلينية ولقائهما، وإلي ترجمة التوراة إلي اليونانية كعمل يتجاوز مجرد الترجمة إلي التمازج بين الله خالق السماوات والأرض من التوراة اليهودية وبين التنوير اليوناني، كما يسميه، هذا التمازج هو بنظر البابا نشوء المسيحية. ولو أكمل البابا إلي فيلون الإسكندري الذي عاش في الإسكندرية قبل المسيح بعقود لادعي مثل أي باحث، ليس بالضرورة أن يكون مؤمناً أن المسيحية هي نتاج تثاقف يهودي يوناني مصري قديم في الإسكندرية، وأنه لا حاجة للمسيح ذاته إلا كرواية، كقصة تقص أربع مرات علي الأقل في العهد الجديد نفسه عن نشوء هذا الدين. هذا النوع من التحليل للمسيحية هو ما جعل فيلسوفاً مسيحياً ورعاً ووجودياً متديناً مثل سيرن كركجور يتمرد علي هيجل حفاظاً علي الإيمان من العقل الفلسفي والتأريخي. وعلي فكرة، لا توجد فكرة هيلينية واحدة يدلي بها المسيح ما عدا بعض أخلاقيات الرواقية ... وفكرة المسيح عن وقوف الإنسان الفرد أمام الله أعمق من أي تصور يوناني فلسفي للفرد. إلا إذا اعتبرنا التجسد، وهو جوهر المسيحية، فكرته. ولكنه لم يعظ بها، بل جسدها. فهي إذاً إما فكرة الله، بالنسبة لمسيحي متدين، وإما فكرة الفلاسفة الذين يتحدث عنهم البابا والذين بحثوا عن علاقة بين إله اليهودية الترانسندنتالي (كما يصف البابا إله الإسلام أعلاه) وبين هذا العالم، أو الدنيا، في فكرة الثالوث والتجسد، وهو ما يؤسس أيضاً لدور الكنيسة ووساطتها، ثم في فكرة افتداء الله لخطايا الناس في هذا العالم بالتضحية بصلب ابنه، التضحية بتجسده، إذا شئنا، من أجلهم.
ولا شك أن التوسط والتجسد والافتداء يتضمن رحمة وعناية إلهية، ولكن ليس هذا شكل الوساطة ولا شكل الرحمة، ولا شكل العناية الإلهية الوحيد الممكن تصوره لدي المؤمنين الباحثين عن إشارات أخري من الله في الديانات التوحيدية التي تفصل مجري الطبيعة والحياة اليومي عن تفاصيل حياة البشر وحياتهم اليومية. فكل الديانات تتضرع إليه، وكل الديانات تجد وساطات مختلفة معه تختلف بين التدين الشعبي والتدين النمطي الأرثوذكسي. كما أن الوساطة وتجاوز الهوة بين محدودية المخلوق ومطلق الخالق ليست ضمانة ضد العنف، فقد تحتكر هي تفسير إرادة الله عندما تكملها الكنسية منذ بطرس الرسول كما تعتقد الكنيسة ذاتها، وكما حصل فعلاً في محاولاتها المتكررة لفرض تفسيرها للحقيقة الإلهية قبل أن تتجذر عملية العلمنة فتفصلها عن قوة الدولة والقسر وتخصخص القرار الديني حقوقياً.
لا توجد نبوة دون توسط بين الله والناس. وفي الوحي المحمدي أيضاً كسر لل«ترانسندنتالية» المطلقة بالوحي ذاته. ولكي يختلف التجسد، في المسيحية عن مجرد شكل خاص من محاولات جسر الهوة السحيقة بين المتناهي واللامتناهي، بين ال «هنا» والعالم الآخر، بين الإنسان والخالق، يجب أن يتحول إلي فكرة «أنطولوجية» فلسفية في تركيب العالم. كأن اللوجوس الإلهي تجسد في الطبيعة ثم في التاريخ، مما يمكن البشر من فهم الطبيعة والتاريخ ومن التوق إلي العقل المطلق في تعرف الفكرة علي ذاتها ... كما في فلسفة هيجل. وهذا تقليد فلسفي معاكس لما طورت فلسفة هيوم وكانت من تقاليد فلسفية وضعية ونسبية وتحليلية مشتقة من مفصل كانط- هيوم في تاريخ الفلسفة الحديثة.
لم يتناول البابا، ولا حتي من منطلقه هو، مسألة مادية وجسدية ومحسوسية إله التوراة، العهد القديم، ثم دعوته للعنف والقتل مرات عدة، وكرهه المعلن لآلهة الكنعانيين، وغيرته السافرة والمرة، ورغبته في الانتقام منها، وحبه البواح، المعلن مرات عدة لرائحة الشواء وتفضيله أجزاء معينة من الذبيحة تقدم له يصفها بدقة متناهية ومكررة. كما لم يتناول البابا انفصال الله الكلي عن العالم في مراحل أخري من تطور اليهودية ... علي الرغم من أنه يعتبر كل ذلك أصلاً من أصول المسيحية قبل لقائها مع الفلسفة اليونانية في فكرة التجسد أو في أخلاقية الموعظة علي الجبل، بل تناول بدلاً عن ذلك مادية الإسلام المدعاة وإيمانه بالقوة. وليس هنالك ما يبرر سلوك البابا هذا سوي اعتبار وثنية الأجزاء الأولي من التوراة جزءاً مما يفترض أن تخفيه وتتستر عليه مقولة «التقاليد اليهود- مسيحية» (Judeo-Christian tradition)، أو نتيجة لمصيبة كون البابا ألمانياً لا يجرؤ إلا علي الاعتذار المستمر لإسرائيل ومشاركتها الموقف من الإسلام. ولا شك أن علوم اليهودية الرسمية أكثر نقدية اتجاه نصوص التوراة من البابا. وهذا أمر مفهوم.
يعتبر البابا في محاضرته التزاوج الحاصل بترجمة التوراة إلي اليونانية مقاربة بين الإيمان والعقل، بين فكرة الله الواحد والتنوير الحقيقي، ويصفها ب «أكثر من مجرد ترجمة، بل هي شاهد نصي وخطوة متميزة منفردة في تاريخ البشارة والرؤيا». بذلك يضفي الحبر الأعظم طابعاً قدسياً علي حدث تاريخي. ولم تشهد الكنيسة علي ما اعتقد مثل هذا التقديس للنزعة المركزية الأوروبية، ومثل هذا الأساس الديني لها منذ الحرب العالمية الثانية. وأقول منذ الحرب العالمية الثانية، لأن النازية في كرهها المعلن للكنيسة الكاثوليكية ككنسية عالمية غير قومية وضعت منظري الكنيسة الألمان مرات عدة في حالة دفاع عن النفس دفعت بعضهم إلي السجن دون تغيير عقيدته، ودفعت بعضهم الآخر إلي كتابات عنصرية مخجلة عن آرية قادة الكنيسة وقديسيها، وفي تبرير لأوروبيتها في مواجهة هجوم المنظر النازي ألفرد روزنبرغ عليها في كتاب أسطورة القرن العشرين الذي نظَّر للثورة الفكرية والقيمية النازية. ولا يمكن إلا أن نري هذه المحاولة الجديدة في تثبيت أوروبية المسيحية والكنيسة في سياق مجاراة الفهم الأمريكي شبه الرسمي لصراع الحضارات، وتثبيت الإسلام كآخر مطلقاً «للتقاليد اليهود- مسيحية» كما تبناها جورج بوش في خطاباته.
في هذا الموقع بالذات يعود بندكت السادس عشر ويؤكد أنه علي هذه الخلفية يستطيع منويل الثاني أن يدعي أن السلوك اللاعقلاني مخالف لطبيعة الله. يؤسس البابا لهذا الادعاء ويستند إليه طوال المحاضرة.
يضع الحبر الأعظم نفسه في إطار التقاليد التي تقود من توما الإكويني (متجاهلاً أن تأثير الفلسفة اليونانية عليه جاء عبر مصفاة الحضارة الإسلامية) والقديس أوغسطين... ونحن نضيف من عندنا: مروراً بلايبنتز وهيجل الذي اعتبر الكاثوليكية تجسداً للعقل في الطريق نحو لقاء المسيحية مع جوهرها في البروتستانتية. منطق البابا، هو المنطق القرسطوي نفسه الذي قاد إلي البروتستانتية دون شك كلقاء مجدد مع ما هو يهودي ونصي في المسيحية وعلي أساس النص، ولكن بعد أن تضمن في ذاته تاريخ المسيحية كله.
إذا كان الله عاقلاً بهذا المعني فلا بد أنه خلق أفضل العوالم الممكنة، كما ادعي لايبنتز، وكما سخر منه فولتير في كنديد. وإذا كانت الطبيعة والتاريخ، بما فيه تاريخ الدين، تمظهرات لعقل إلهي في التاريخ كما عند هيجل، فلا بد أن يترتب علي ذلك أن الدين عقلي وعقلاني، بل أن يختزل الدين إلي تاريخ الدين، ويتحول إلي جزء من التاريخ البشري له مهمة ومرحلة من تمظهرات الروح تكتسب معناها من موقعها في هذا التسلسل التاريخي.
يخالف البابا في المحاضرة تقاليد أوروبية أخري من دون سكوتس إلي شلنج في فهم حرية الله وعدم تشابهه مع الإنسان، مؤكداً أن الشبه في العقل المشترك علي الرغم من الفرق بين الإنساني والإلهي، بين اللا- متناهي والمتناهي، التشابه بين الله والإنسان الذي خلقه علي صورته ومثاله هو أساس قدرتنا علي الفهم. «لا يصبح الله أكثر إلوهية عندما ندفعه بعيداً عنا»، يقول البابا. ولكنه بالتأكيد لا يصبح أكثر ألوهية عندما نقربه منا نجيب نحن، وإلا اعتبر كل أصولي ذاته متلقياً للوحي مباشرة، وأنه علي معرفة، عقلية إذا شاء البابا، بإرادة الله فيحكم وينهي بموجبها. وما أكده الإسلام في هذه المسألة تحديداً أن محمداً هو آخر الأنبياء والمرسلين قاطعاً الطريق علي كل من يدعي فيما بعد معرفة إرادة الله كأنه يستوحيها من الله نفسه. ليست المسألة إذاً القرب والبعد عن الله بقدر ما هي كيفية استخدام هذا القرب والتقرب، وسياقه التاريخي، ووظيفته السياسية وطبيعة القوي التي تقف من ورائه. وهذه ليست مسألة ثيولوجية ولا حتي فلسفية بحتة.
تقوم الصوفية المسيحية والإسلامية علي حد سواء علي الإيمان كمحبة الله، وعلي التواصل بين ال «هنا» و«الآن»، والما-ورائي المطلق بواسطة فيض الحب. والمحبة هنا أرقي من المعرفة. وهذا أقرب من جوهر المسيحية عند بولس الرسول علي الأقل، الذي يعتبر الحب أكثر اقتراباً من جوهر الله من المعرفة. ولكن البابا يطوق هذا القرب بين جميع الصوفيات الإسلامية وبين رسالة المسيحية والنساك الشرقيين والرهبنات الشرقية العظيمة والفرانسيسكانية الغربية العظيمة، بالقول إنه صحيح أنه حب عند بولس الرسول، ولكنه حب لله، حب اللوجوس، العقل. وإذا ترجمنا ما يقوله البابا إلي اليونانية حب (philos) وعقل (logos) نبقي مع الدين كمحبة العقل (philologos) وهو مصطلح قريب من (philosophia) وتعني محبة الحكمة.
ونحسب أن هيجل يتكلم عندما يؤكد البابا أن التقارب بين الإيمان التوراتي والفلسفة اليونانية هو حدث مقرر، ليس فقط في تاريخ الأديان، بل في التاريخ العالمي، ولذلك يقول البابا إنه ليس مفاجئاً أنه فيما عدا الأصول الشرقية للمسيحية وبعض التطورات المهمة في الشرق اتخذت المسيحية شكلها التاريخي الذي يميزها عن غيرها في أوروبا. ويقول البابا إنه يمكن وضع هذا السياق التاريخي بالعكس، أو صياغته بشكل مقلوب: «هذا التحول يضاف إليه الميراث الروماني خلق أوروبا، وسوف يبقي أساس ما يمكن بحق تسميته أوروبا». ويحق لنا أن نقدر هنا ونستتنج من كلامه (ونحن نقدِّر أن عبارة «تسميته بحق» هنا جاءت لإخراج غير المسيحيين من تعريف «أوروبا الحقيقية» في مقابل أوروبا الجغرافية، فألبانيا وكوسوفو وتركيا ليست أوروبا في نظر البابا، وقد عبرت عنها معارضته العلنية لضم تركيا إلي الاتحاد الأوروبي)، أما إسرائيل فهي علي ما يبدو جزء لا يتجزأ من أوروبا.
علي كل حال، سواء وافقنا علي هذه الآراء أو خالفناها، فإن هذا كلام باحث، وليس كلام «قائد روحي» ورأس كنيسة لها أتباع في آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا. وربما نسي الباحث في اللاهوت راتسنجر وظيفته الجديدة، كونه أصبح البابا بندكت السادس عشر. وحتي لو صح ما يقول، فإن هذا يقوله باحث لا قائد كنيسة لأتباعها غير الأوروبيين. كل هذا لو كان يفصل بين العلم والإيمان، ولكن البابا لا يفصل. إذاً فمركزية أوروبا عنده حقيقة إيمانية، وليست مجرد حدث تاريخي، أو صيرورة تاريخية. وتحويل أوروبية المسيحية إلي ركن من أركان الإيمان في محاضرة لا يعني إلا أن البابا يقف أيديولوجيا في موقع معين في إطار الصراع في عالمنا.
ويتصدي البابا بالنقد لمحاولات نزع الهيلينية عن المسيحية (dehellenization) ويلخصها بثلاث محاولات عبر التاريخ. أولها وأهمها محاولة الإصلاحيين، بمن فيهم مارتن لوثر، عبر محاولة تنقية العقيدة من ميتافيزيقا اللاهوت القرسطوي المعتمدة في أساسها علي تقاليد الفلسفة اليونانية الأرسطية، والعودة إلي النص المقدس (sola scriptura) ووحدانية النص، لتنقية العقيدة من «الشوائب» التي علقت بها.
هنا يتورط البابا في نقاش فلسفي مع كانط معتبراً فلسفته التي تحدد تواضع العقل ونسبيته في سلسلة نقد العقل، والتي تفرز مكاناً للدين في العقل العملي والأخلاق لا في مجالات المعرفة، مقدمة للفصل بين العلم والإيمان، وأساساً فلسفياً للبروتستانتية لم يتوقعه الإصلاحيون أنفسهم. فبموجب نقد العقل ووضع حدوده وتنقيته عند كانط، لا الدين منظومة لفهم الواقع ولا العلم يصلح لإثبات وجود الله أو البحث في المسائل الإلهية. وليست هذه وسيلة لتنقية المسيحية من الهيلينية كما يدعي البابا، بل بالعكس تماماً. والمزج والتوليف الذي يتحدث عنه البابا بالذات هو نموذج يصلح لتفسير نشوء المسيحية، وقد يكون مقبولاً حتي علي من يوافق كانط رأيه، ولكنه ليس أحد أسس الإيمان أو العقيدة كما يحاجج الحبر الأعظم في محاضرته.
ما طرحه هيوم من تناقضات العقل المطلق، ثم إجابات كانط القائمة علي نقد العقل والأسئلة التي طرحها وفصلها عن بعضها البعض من نوع: «ماذا أستطيع أن أعرف؟»، «ماذا علي أن أفعل؟» «كيف يمكن ممارسة الدين في حدود العقل؟» ... إلخ، كانت الأساس الوحيد الممكن لنظرية في الدين تؤسسه عقلياً علي ضرورات أخلاقية وجودية للمجتمع في «نقد العقل العملي». وهذا يفسح مجالاً للعلمنة، كما يفسح مجالاً للتدين الورع غير القائم علي حسابات إلي جانب التدين المحافظ المؤسسي المحسوب عقلياً بحاجات اجتماعية وأخلاقية، ربما من نوع تدين البابا ذاته، والله أعلم.
لا يعني القرار العقلي في مسألة ممارسة الدين في حدود العقل عقلانية الدين، ولا يعني عقلنة القرار الإيماني الحر. وهذا النقد الكانطي للعقل ووضع حدوده هو الأساس لفصل القرار العلمي الذي يمكن تفنيده عن القرار الأخلاقي أو الديني الذي لا يمكن تفنيده ولا إثباته كما يشرح كارل بوبر في كتاب منطق البحث. لقد أسس هذا التحول الفلسفي لتيارات فلسفية غير ثيولوجية، بمعني أنها تبتعد عن أن تكون مجرد منظومة فلسفية لنقد وتأكيد حقيقة المسيحية في الوقت ذاته.
ومكن هذا الفصل من تطهير الدين من محاولات إثبات صحته وخطأ ديانات أخري، ودافع عن الله من محاولات إثبات وجوده السخيفة، وجعل الإيمان خياراً حراً يقترب من طبيعة الأخلاق. المؤمن ليس علي صواب بإيمانه، بل علي إيمان أو علي ثواب. وغير المؤمن ليس علي خطأ. والبابا ليس علي خطأ أو صواب بإيمانه بالمسيح والحلول والتجسد والقيامة. فلا يمكن إثبات صحة هذه أو خطئها. ولا يمكن التأكد من أنها تقود مثل تعليمات علي خارطة بوثوق إلي الجنة. ليست لدينا طريقة علمية للتأكد من ذلك أو نفيه. ولكنه علي خطأ في تعميماته عن الإسلام، وبالإمكان تفنيد هذه التعميمات علمياً، أي إثبات خطئها.
ومن ناحية أخري، لا شك أن فصل المقدس عن العلم والسياسة والدولة وغيرها من شئون الطبيعة والمجتمع التي تحتاج إلي إحكام العقل النقدي، ووجدت تطويراً لها عند فيبر وآخرين، يدفع ثمن العلمنة ليس في أصولية دينية خارج المؤسسة الكنسية فحسب، بل أيضاً في نزعة لتقديس الدنيوي في الحركات السياسية القومية وغيرها. ولا شك في أن الكنيسة الكاثوليكية حافظت علي توازن ما في هذا السياق بين نتيجتي عملية العلمنة ككنيسة عالمية. ولكن الخطر يكمن حالياً في نزعة الحبر الأعظم لأن يضعها علي مسار تنافسي مع أصوليات بروتستانتية وفي شق فجوة مطلقة بينها وبين ديانة عالمية أخري.
المرحلة الثانية هي مرحلة اللاهوت الليبرالي في القرنين التاسع عشر والعشرين، وممثلها الأبرز رودلف فون هارنك. وقد حاول الأخير تنقية المسيحية مما اعتبره شوائب ميتافيزيقية لا أساس علمياً أو إيمانياً لها في الطريق إلي اعتبار المسيحية قمة الديانات الإنسانية، هي حياة يسوع المسيح وتعاليمه ذاتها، منطلقاً من تمييز باسكال بين إله الفلاسفة وإله إبراهيم واسحق ويعقوب. ويعتبر المسيحية مسألة أخلاق لا مسألة عبادة. ويعلل البابا إقصاء الدين عن العلم والتحليل العلمي في هذه المرحلة بتطور العلم الحديث. وهو يحصر العلم بين افتراض تشابه بين عقلنا وتركيب المادة في لغة الرياضيات وبين التجربة ذاتها المستندة إلي الإثبات والتفنيد الإمبيريقيين، أي بين الاستقراء والاستدلال. ولا أدري لماذا يحتاج البابا إلي هذه التعريفات المبسطة للعلم لكي يناقش الموضوع. فمثلاً الدين ذاته كظاهرة اجتماعية، أي كتدين، يخضع للتقييم العلمي كظاهرة بحثية حتي دون رياضيات وبمناهج أخري، ولكن مشكلة البابا هي اعتباره التعليل العلمي جزءاً من الإيمان ذاته، وهذا نقيض العلم ونقيض الإيمان، وهو يقضي علي خصوصيتهما.
أما المحاولة الثالثة في عملية نزع الهيلينية عن المسيحية، فتنتج عن التعددية الثقافية، عن محاولة جعل التركيبة التوراتية الهيلينية مسألة خصوصية ثقافية أوروبية محضة لا تلزم المسيحيين في سياقات حضارية أخري. وبموجب هذه المحاولة من حق هؤلاء أن يبحثوا عن روابط ثقافية أخري تؤسس للمسيحية في سياق حضارتهم، وذلك بالعودة إلي العهد الجديد البسيط، وسيرة يسوع المسيح، ثم ربطه بحضارتهم. ولكن البابا لا يوافق علي هذا الجهد. إذ يقول إن العهد الجديد كتب باليونانية، ولا معني لهذا الربط دون رؤية «بصمات الروح اليونانية فيه» علي حد تعبيره. ويقول البابا في محاضرته: «صحيح أن هنالك عناصر في تطور الكنيسة المبكرة لا يلزم أن تندمج في كل الثقافات، ومع ذلك، فإن الحسم الأساس حول العلاقة بين الإيمان واستخدام العقل البشري هو جزء من الإيمان ذاته».
يرتبك البابا بين حاجة العلم لأن يستفيد من الإصغاء لإيقاع التجربة الدينية في عملية المعرفة، وبين اعتبار الجهد العقلي أعلاه جزءاً من عملية الإيمان ذاتها. وفي نهاية محاضرته يعتبر البابا العقل الكوني الكلي «لوجوس» هو أيضاً الأساس لحوار الثقافات، ولا نعرف هل يقصد هنا الحوار بين الثقافة الدينية والثقافة العلمانية في أوروبا ذاتها، أم حوار الثقافات بين أوروبا وغيرها، وفي الحالتين تأسيس الحوار علي العقل، كما يرغب البابا، يختلف عن اعتبار الإيمان مسألة قرار عقلاني.
5 حول عقلانية ملحة ممكنة:
لا تتميز التقاليد الدينية «اليهود- مسيحية» المدعاة بالعقلانية في مقابل الإسلام. والإسلام كدين ينتمي، برأينا، إلي التقاليد نفسها. ولو ادعينا ما هو صحيح، أن الإسلام، لاهوتياً، أقل خصومة مع اليهودية من خصومة المسيحية معها، لاستدركنا فوراً أن الخصومة اللاهوتية الدموية بالذات بين اليهودية والمسيحية هي الدليل علي التقارب، فهي خصومة علي ما هو مشترك، علي تفسير القضايا نفسها، وأهمها عودة المسيح، والمسيح الكذاب، وصلب المسيح... وهل جاءت المسيحية لتنفي التلمود أم لتكمله كما قال المسيح نفسه... وهذا يعني، علي كل حال، أن حكاية التقاليد اليهود- مسيحية لم تكن حكاية عقل وتعقلن فقط، وأن العنف الدموي بينهما كان سيد الموقف مرات عدة. فما يميز المسيحية واليهودية أن كلاً منهما تدعي أنها تمثل الحقيقة نفسها، والعلاقة إذاً علاقة نفي علي القاعدة نفسها.
ومن الرمزية التاريخية أن الحملات الصليبية كانت تجتاح قري وبلدات يهودية في وسط أوروبا، وتعمل قي سكانها القتل والتنكيل قبل إكمال الطريق إلي محاربة المسلمين. ونحن لن نحاول في هذا النص أن نفسر حتي هذا العنف بنصوص دينية أو دعوات بابوية. فهنالك فرق بين أن يبرر العنف من يستخدم العنف، وذلك بنصوص دينية وخلافات لاهوتية، وأن يفسر الباحث هذا السلوك بهذه التبريرات. التفسير البحثي أمر، والتبرير الذي يستخدمه الفاعلون أمر آخر.
ليس العقل في الدين هو ما ميز الثقافة و«التقاليد اليهود- مسيحية» عن الإسلامية. وإذا كان من مميز ديني له أثر أو فعل ثقافي تكويني، وفي الوقت نفسه تتشارك فيه اليهودية والمسيحية، ويتكرر فيهما نصاً، فإنه لا يميزهما عن الإسلام فحسب، بل عن الفلسفة الهيلينية أيضاً. إنه عنصر غير عقلاني يختلفان فيه عن الإسلام الذي يفتقد إليه، كما تفتقد إليه الفلسفة اليونانية، ولم يكن لهذا المميز أثر عقلاني في التاريخ، بل أثر هدام: إنه فكرة الخلاص، ونهاية التاريخ، فكرة رؤية تاريخ العالم كتقدم من بداية إلي نهاية معروفة سلفاً.
ويجمع عدد كبير من المفكرين والمؤرخين الغربيين أن هنالك فكرة موجهة مشتركة بين النصوص اليهودية والمسيحية، تركت أثراً متراكماً كبيراً علي فهم حركة التاريخ وجعلت له معني، وقد تحولت إلي مصدر حضاري ليس فقط لأفكار علمانية ولفكرة التقدم التصاعدي، ولفلسفة التاريخ التي لم تكن قائمة قبل ذلك في الفلسفة اليونانية وسواها، بل أيضاً لفكرة خلاص البشرية من العذاب في نهاية للتاريخ تسبقها كوارث.
من هذه الزاوية يجري تاريخ آخر مقدس خلف الأحداث والتفاصيل العادية وغير العادية وخلف الكوارث والحروب لا يراه إلا المؤمن. فهو قادر حتي علي تفسير كارثة كأمر مفيد أنه يقدم التاريخ من غايته والإنسانية من لقائها مع باريها.
لم تعرف الفلسفة اليونانية فكرة فلسفة التاريخ، ولا بحثت عن تاريخ موحد للعالم. ولم تبحث عن غاية أو قصد للتاريخ. ولم تدفع الناس إلي الالتحام مع معني مفترض للتاريخ يمنحهم معني لحياتهم. هذه فكرة يهودية مسيحية بامتياز. ولم يشمل النص القرآني أي وعد بخلاص علي الأرض، ولم يتضمن أو يؤشر إلي نهاية سعيدة للتاريخ في هذه الدنيا، يتقدم العالم نحوها.
وبالطبع، يجب أن نضيف هنا أنه من زاوية أخري، فإن هذا العنصر المكون تضمن فكرة التقدم التصاعدي التي ساهمت في تفاعلات أخري، منها تبرير التطور والتقدم كقيمة إيجابية. وإن تبرير السعي نحو حياة أفضل وأعدل في هذه الدنيا له ثمن، ولكن كان أيضاً دافعاً لأمور إيجابية كثيرة. وحتي بمفهومه كأوتوبيا، ليست الأوتوبيا كلها سلبيات، ولم تؤدِّ دائماً إلي تأسيس فكر شمولي.
ولا شك في أن النص ليس كل شيء. فلا تاريخ الحضارة الغربية محكوم بهذه الفكرة، ولا لبثت الحضارة الإسلامية دونها طويلاً. فالحركات التي تستعيد مجداً غابراً وتريد عودته في المستقبل تبحث عن أوتوبيا إسلامية خلاصية بمعني ما، وإن كانت تستلهمها من ماضٍ فردوسي عادل، وملكوت إلهي ساد في مرحلة النبوة والخلافة الراشدة وتسقطها علي المستقبل كهدف. وقد نشأت أيضاً فكرة المهدية واستندت علي نصوص قرآنية، وفكرة عودة الإمام في مراحل مختلفة لدي فرق شيعية، ولم تخلُ منها أيضاً فرق سنية.
ونحن طبعاً لا نوافق علي أن الفكرة الواردة عند سفر النبي أشعيا في العهد القديم، والمتكررة في رؤيا يوحنا اللاهوتي هي فاعل نصي مكون للثقافة المسيحية لا مهرب منه، بل نقول إن هذه الفكرة تحولت بالتراكم التاريخي إلي عنصر مكون في تأليف الحركات الدينية السياسية في الغرب، وفي بعض الحركات الفكرية العلمانية الخلاصية.
منذ القرون الوسطي نشأت عشرات حركات النبوة الكاذبة والحركات الألفية ذات الطابع الديني التي تعتمد علي هذه النصوص لتبحث عن علامات في الأحداث مطابقة لما رآه يوحنا لكي تحدد نهاية التاريخ وقدوم كوارث وحروب (حكم ال «أنتي كريست» في بعض تفسيرات الكنيسة وحكمه الكافر الظالم) تتبعها عودة المسيح إلي الأرض عند يوحنا اللاهوتي (مجيء المسيح عند أشعيا) وإقامة ملكوت الله علي الأرض وتخليص البشرية من عذابها.
أما الكنيسة الكاثوليكية فقد أبدت اهتماماً بالادعاءات حول بروز علامات النهاية، وغالباً ما أوفدت مبعوثين عنها لفحصها في المدن والقري البعيدة عن المركز حيث ظهر مدعو النبوة وقادة الحركات الألفية. فهي القيمة علي النص، ولم يكن لديها مانع من تمييز العلامات السلبية القاضية بوجود ال«أنتي كريست»، وذلك لملاحقة خصومها. ولكنها لم تنجر وراء الحركات الألفية الخلاصية عادة، بل حاربتها ليس من منطلق عقلي فحسب، بل دفاعا عن مصالحها. فقد نشأت هذه الحركات غالباً خارج الكنيسة أو من خلال عمليات تمرد رهبانية عليها وعلي فسادها ورموزها وتمسكها بماديات العالم وسلطاته السياسية وجاهه وثرواته. وقد لاحقت الكنيسة هذه الحركات واتهمتها بالهرطقة دفاعاً عن مصالحها هي، وتكريس دورها في الوساطة بين الله والنص الديني من جهة، والناس من جهة أخري. ومن هنا لعبت الكنيسة الكاثوليكية في موقفها المحافظ وهرميتها المتماسكة دوراً عقلانياً من الناحية الموضوعية.
وقد تحولت هذه الفكرة، برأي باحثين غربيين، إلي عنصر حضاري مكون يدفع إلي رؤية معني للتاريخ في تقدمه نحو الخلاص حتي في الفكر العلماني التحرري الذي لا يري إمكانية التعامل مع الأحداث التاريخية دون معني ودون أن تصب في النهاية لصالح هدف موجه ما، أو غاية يسعي إليها التاريخ، وتقود إليها أفعال الناس حتي دون وعي منهم، أو دون أن يعلموا بحقيقة دورهم.
ونحن نجد أثر ذلك في الفلسفة الهيجلية للتاريخ، كما نجده في الجانب الخلاصي من الماركسية والحركات الشيوعية التي تسعي نحو جنة الله علي الأرض. وهنالك دراسات واسعة ومدرسة كاملة في شرح النازية باعتبارها حركة ألفية لا يمكن فهمها إلا من خلال موضعتها في هذا التقليد المسيحي، أو اليهودو-مسيحي بتعابير الحقبة الراهنة، لعائد إلي القرون الوسطي. إنها حركات تميز ليس بين تقدمي ورجعي في فهم حركة التاريخ فحسب، وإنما أيضا بين من يعي جوهر التاريخ ويعي دوره فيها ومن لا يعيه. والطليعة المنظمة هي التي تعي دورها وتنسجم مع حتمية الحركة التاريخية. والحتمية حقيقة مطلقة. إنها تنسجم في فكرها مع الحقيقة ومع تاريخ الفكر وتاريخ العالم ومعناه وغايته، مؤلفة فكراً شمولياً يحتكر الحقيقة ويبرر العنف دونما رادع إذا كان يساهم في تعجيل الوصول إلي الهدف، أو إذا كان ينسجم مع غاية التاريخ وهدفه الأسمي.
وقد ترافقت عملية دمقرطة أي فكر أو حركة شمولية مع عملية نزع خلاصيتها وتحريرها من هذا الفهم الأوحد لمعني التاريخ وغايته.
هنا أيضاً لعبت المؤسسة الكنسية الرسمية دوراً تشكيكياً بل معارضاً بقوة ضد هذا النوع من الحركات الشمولية أكثر حتي من معارضتها للحركات العلمانية الليبرالية، فخلافا للعلمانية الليبرالية تكاد الأولي تطرح ديناً إلحادياً بديلاً، وتنافس الكنيسة وتقاليدها في الثواب والعقاب والخلاص الإلهي، وتعارض النظام الاجتماعي الذي تشكل الكنيسة جزءاً منه، وتعتبر الكنيسة أيديولوجية كاذبة تمنع المظلومين من رؤية مصالحهم الحقيقية كما في حالة الشيوعية.
ودون الدخول في تفاصيل واستثناءات، نستطيع أن ندعي أنه بين الحركات الدينية الخلاصية الذاهبة إلي حرفية نص أشعيا ورؤيا يوحنا اللاهوتي كنظريات خلاصية، وبين الحركات العلمانية الخلاصية الشمولية، وقفت الكنيسة الكاثوليكية في مجمل دورها التاريخي موقفاً محافظاً وسطاً، ربما يصح أن نسميه موقفاً لا ينجر بسهولة إلي اللاعقلانية السياسية العنيفة الطابع.
في إسرائيل تتبني الفكرة الخلاصية من النص التوراتي والثقافة الخلاصية بنهاية التاريخ حركات يهودية استيطانية تنكل بالفلسطينيين وتصادر وطنهم في انسجام مع حركة التاريخ ومعناه وتعجيل الخلاص كما يعرّفونه، وفي الولايات المتحدة وبريطانيا تنتشر منذ القرن الماضي (التاسع عشر) حركات وأمزجة مسيحية صهيونية تسعي لعقد لقاء مع نهاية التاريخ، وتنشط سياسياً وثقافياً في التحريض علي الإسلام والمسلمين، وتعتبر إقامة إسرائيل فعلاً ذا معني إلهي مقدس يتجاوز الحدث الفعلي وآلام الناس الفعليين، وتعتبر دعم إسرائيل فريضة دينية مقدسة تنسجم مع حركة عودة المسيح المنتظرة.
في الماضي كانت الكنيسة الكاثوليكية تحارب مثل هذه الحركات، وتعلن عليها الحرمان. ونحن نعرف أنه لديها في يومنا أدوات من نوع الحرمان البابوي. وليس من حنين لدينا أو لدي غيرنا أن تعود للعب هذا الدور. ولكن بين عدم إمكانية إعلان الحرمان عليها ومحاربتها كما في الماضي، وبين التحديات التي وضعها البابا في محاضرته، ضاعت مهمة الكنيسة العقلانية الحقيقية الممكنة.
هنا التحدي البابوي. فعلي الرغم من كل ما قيل أعلاه، تستطيع الكنيسة الكاثوليكية، بمن فيها من يقف علي رأسها، أن تلعب دوراً في عقلنة السلوك الديني، أو أن يكون لها موضوعياً دور عقلاني في تلك القضية بالذات التي كانت مصدراً ثقافياً لجزء كبير من العنف السياسي في عالمنا.
كان يوم جمعة حينما بدأت بكتابة هذا المقال، وقد تسلل إلي مسامعي، بل اقتحمها أثناء الكتابة صوت خطيب الجمعة في مسجد قرب منزلي. وكان خطيب المنبر جازماً في وعده بأنه كما احتلت الخلافة القسطنطينية، بلد الملك البيزنطي، وفرضت عليها دين الإسلام الحنيف، فإن الخلافة القادمة سوف تفتح روما والفاتيكان، و«هذا هو الرد الحقيقي علي البابا». لا يقاس الخطيب الذي سمعته صدفة، أو عنوة، بالبابا من حيث المسئولية عن كلامه وحجم الضرر، ولكنه كان يوم جمعة أعلن كيوم غضب. وكان الخطيب غاضباً، أو هكذا وقع كلامه علي مسامعي البشرية المحدودة الفهم علي الأقل.
الهوامش:
1- Jürgen Habermas & Joseph Ratzinger (Pope Benedict XVI.) - Dialektik der Saekularisierung. Uber Vernunft und Religion (Freiburg, Verlag Herder,2005)
Zur Debatte, Themen der Katholischen Akademie in Bayern, 34 Jahrgang, Heft1, Muenchen 2004.
2 - Karl Loewith, Christentum, Geschichte und Philosophie, in: Saemtliche Schriften,( Stuttgart: Metzler (1983) 433-451.
يثور الكاردينال بشكل خاص
ضد ذلك «الإرهاب الإسلامي» الذي يحاول
أن يبرر نفسه أخلاقياً ويتساءل مستنتجاً: «ألا يجب
أن يوضع الدين تحت عباءة العقل،
وأن توضع له حدود؟»
انتشرت أدبيات تُؤوّل آيات قرآنية
كأنها تتضمن ما اكتشفته نظريات علمية
عن تكوّن الجنين في الرحم، ونظريات الوراثة،
وغيرها. ولسبب ما يأتي تفسير الآية دائماً
بأثر رجعي بعد أن تم الاكتشاف
يحاول البابا أن يقدم الكنيسة
أداة ناجعة في بناء هوية أوروبا فيما
يسميه هو حوار الثقافات، وهو وجه آخر لصراع
الحضارات. كما يحاول أن يقدمها كأداة
عقلنة عريقة ومتزنة ومحافظة
لماذا قرر المحرر والمحاضر
أن مثقفاً إسلامياً من القرن الرابع عشر
لم يتأثر ولم يتفاعل مع الفلسفة اليونانية؟
هذا لغز لا أستطيع له حلاً
من أين للمحرر والبابا هذا
الجزم بأن طبيعة الله قد تكون غير
عقلانية في الإسلام؟ من ابن حزم وحده؟ هذا لغز
حقيقي آخر بالنسبة لباحث يريد
أن يفهم محاضرة البابا
لا يخلو دين من مسلمات
إيمانية، ومنها تنطلق المحاكمات العقلية
المنطقية. وحتي لو اشتقت الاستنتاجات عقلياً
بالاستدلال، فإن هذه الاستنتاجات
لا تعني الكثير لغير المؤمن
لم يتناول البابا، مسألة
مادية وجسدية ومحسوسية
إله التوراة، العهد القديم، ثم دعوته للعنف والقتل
مرات عدة، وغيرته السافرة والمرة،
ورغبته في الانتقام منها
هنالك فرق بين أن يبرر العنف من
يستخدم العنف، وذلك بنصوص دينية
وخلافات لاهوتية، وأن يفسر الباحث هذا السلوك
بهذه التبريرات. التفسير البحثي أمر، والتبرير
الذي يستخدمه الفاعلون أمر آخر.