الشركات فى سباقها الوحشى إلى الربح و السلطة
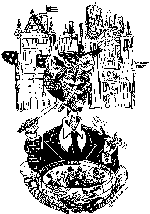
عندما تناولت هذا الكتاب من فوق أحد رفوف المكتبة ونظرت فيه نظرة فاحصة ثم قررت أن أقتني نسخة منه ــ لم يتبين لي من أول لحظة أنه الكتاب الذي علي أساسه وُضع ذلك الفيلم التسجيلي الذي أثار ضجة إعلامية كبيرة.. وحصل علي جوائز عالمية كثيرة من بينها جائزة مهرجان «كان» السينمائي لعام 2004م.. وأقصد به فيلم «فهرنهايت 11/9».
والشركة المعنية هنا هي الشركة المساهمة.. وهي مؤسسة اقتصادية ضخمة ذات تركيبة خاصة، تحكمها مجموعة من القواعد ولها قانون خاص يحدد وجودها وصلاحياتها وأوجه نشاطها.. ولها هدف محدد هو السعي بكل وسيلة لتحقيق أقصي قدر من الربح لحملة الأسهم فيها.. فأين هي المشكلة إذن؟
يجيب المؤلف بأن هذا النوع من الشركات (بلا استثناء).. وبحكم تصميمه وقانونه الخاصين قد أثبت تاريخيا وفي مجال الممارسة العملية أنه خطر علي المجتمعات وعلي البيئة.. وأنه قد تسبب ــ ولا يزال ــ في كوارث كثيرة وخطيرة علي حياة البشر بل علي حياة الكوكب الأرضي برمته.
وهذا ما دفع «جوئل باكان» مؤلف الكتاب إلي اعتبار الشركة المساهمة كائنًا شاذًا يتميز بسلوك مرضي بالغ الخطورة.. وليس هذا كلام ناشط يساري ولا متحمس من أنصار البيئة، بل كلام أستاذ القانون بجامعة «بريتش كولومبيا» ومفكر عالمي مشهور.
لقد أثار سلوك الشركة الخطر كثيرًا من الإشكاليات والتساؤلات.. وهذا الكتاب محاولة جادة وجريئة للإجابة علي هذه التساؤلات:
ــ كيف أصبحت الشركة بهذه القوة الغاشمة؟
ــ ما طبيعة هذه الشخصية بالباثولوجية؟
ــ وكيف تؤثر بنفوذها وقوتها الطاغية علي البيئة والمجتمعات؟
ــ وأخيرًا: ماذا ينبغي عمله لكبح جماح هذا الكائن الشرس ومواجهة مخاطره؟
ولأن المؤلف يوجه كتابه هذا إلي الجماهير العريضة وليس للمتخصصين وحدهم فقد تجنب استخدام المصطلحات الأكاديمية المستغلقة.. دون تضحية بالدقة التي يتطلبها البحث العلمي. ولكي يوضح مجاله الموضوعي يقول: إنني معني بشركات الأعمال التجارية والصناعية (الأنجلو أمريكية) مستبعدًا الشركات الصغيرة المحدودة.. والشركات التي لا تقوم علي الربح.. وكذا التي يملكها فرد واحد ملكية شخصية سواء كانت صغيرة أو كبيرة. أما لماذا يركز علي الشركات الأنجلو أمريكية؟ فجوابه: إنها أكبر الشركات العالمية وأكثرها قوة وهي التي جاءت العولمة لتنشر آثارها المدمرة فيما وراء حدودها القومية.
النشأة والتطور:
يرجع ظهور الشركات المساهمة لأول مرة في بريطانيا إلي القرن السادس عشر الميلادي وهي غير الشركات التي سادت قبلها، وكانت تقوم علي أكتاف عدد قليل من الناس جمعهم معًا الولاء الشخصي والثقة المتبادلة، فوضعوا أموالهم في صندوق واحد لإنشاء شركات يملكونها ويديرونها بأنفسهم.
أما الشركة المساهمة فهي نمط آخر: الملكية فيها منفصلة عن الإدارة.. بمعني أن هناك مجموعة من المديرين يقومون بإدارة الشركة بينما مجموعة أخري من حملة الأسهم هم الذين يملكونها.. وهذه التركيبة العجيبة بطبيعتها معرضة للفساد ولتفريخ الجرائم كما يعتقد كثير من المفكرين والباحثين. ويضرب علي هذا مثالاً بواحدة من أقدم الشركات الإنجليزية للنقل البحري التي أنشئت عام 1710م وجعلت نشاطها في أمريكا الجنوبية.. كانت تعمل في تجارة الرقيق ولكنها زعمت لحملة الأسهم أنها تورد الجبنة الشستر والشمع والمخلل وغير ذلك من السلع الإنجليزية الرخيصة، وتعود محملة بمكاسب هائلة من الذهب والفضة.. وباختصار شديد: انهارت الشركة بسبب الفساد والكساد والطاعون، وتبخرت أموال المساهمين في غمضة عين فتفجرت ثورة عنيفة في «وست منستر» حي الإدارات الحكومية والبرلمان.. وقتل أحد حملة الأسهم مدير الشركة مما اضطر الملك للعودة مسرعًا إلي لندن من رحلة كان يقوم بها، حيث عقد البرلمان الذي استدعي رؤساء الشركة وحاكمهم، وأصدر في النهاية قانونًا يجرم إنشاء شركة مساهمة.. منذ هذا التاريخ وعلي مدي ثلاثمائة عام تالية ظلت الشركات تحشد قوي كبيرة رفعتها فوق سلطة الحكومات.
وهكذا تحولت الشركات المساهمة التي استطاعت الحكومة الإنجليزية إلغاءها بجرة قلم سنة 1720 ــ إلي كائن خرافي بالغ الشراسة يسيطر علي الحكومات والمجتمعات. فكيف تمكنت الشركات من قوتها الهائلة التي أصبحت تمتلكها الآن؟
يقول المؤلف: أصحاب رءوس الأموال تحت غواية الدعاية بحصد أرباح بلا حدود كان يدفعهم إلي المال نهم غير محدود.. ولكن عائقًا قانونيا كان يحد من قدرة الشركات علي اجتذاب مزيد من حملة الأسهم.. ذلك لأن القانون القديم للشركات اعتبر حملة الأسهم مسئولين عن أخطاء إدارة الشركات وديونها، فإذا صدر حكم بتسديد هذه الديون وقع العزم علي حملة الأسهم، لا بسبب فقدانهم لقيمة الأسهم فقط وإنما قد يخرجون من كل ما يملكون من مال وعقارات أخري حتي يتم تسديد الديون. فماذا فعلت الشركات؟ ظلت تضغط علي الحكومات لاستصدار قانون (المسئولية المحدودة) الذي بمقتضاه يصبح حملة الأسهم غير مسئولين عن أخطاء الشركة وديونها إلا في حدود ما يملكون فيها من أسهم.
منذ هذه اللحظة من عام 1898م بدأت تتدفق علي الشركات الأمريكية أموال طائلة.. كما تدفق عليها حملة الأسهم من كل مكان.. وشهدت السنوات الست التالية عصر الشركات المساهمة العملاقة التي تقلص عددها خلال عمليات اندماج كبري من 1800 شركة إلي 157 شركة فقط. وخلال القرن العشرين تضاعف عدد حملة الأسهم من عشرات الألوف إلي مئات الألوف من الأفراد.
وهنا تبرز مشكلة أخري: وهي أن هذا العدد الهائل من البشر ليس لهم أي تأثير علي القرارات التي تصدرها إدارة الشركة باسمهم.. لماذا؟
يقول المؤلف: لأنهم أفراد مبعثرون في مواقع متباعدة لا رابطة بينهم أصبحوا شخصيات مجهولة.. تبددت قوتهم وأصبح من المستحيل عليهم أن يتصرفوا تصرفًا جمعيا. هذا الوضع كان من شأنه أن يطلق يد رجال الإدارة في اتخاذ القرارات والسيطرة علي هذه الشركات سيطرة مطلقة. ومن ثم برزت مشكلة قانونية وهي: من المسئول عن سلوك الشركة خصوصًا أنه قد أصبح من الصعب الإشارة إلي شخص بعينه باعتباره مسئولاً عن الشركة لأن القرارات تتخذ بشكل لا يمكن تحديد شخص بعينه مسئولاً عن هذه القرارات.. فما المخرج من هذا المأزق؟ لقد قرر المشرعون أن الشركة المساهمة «شخصية اعتبارية» ومن ثم فهي مسئولة عن نفسها أمام القانون والمحاكم. يعني أصبحت الشركة المساهمة كما قال أحد أساتذة القانون سنة 1911: كائنًا حرًا مستقلاً أمام القانون.
ويعلق المؤلف قائلاً: أي كائن بشع غريب هذا الذي لا قلب له ولا عاطفة ولا قدرة علي التعبير عن المشاعر الإنسانية ولا الإحساس بمشاعر الآخرين. فلما أدرك الناس هذه الحقيقة تزايدت عندهم مشاعر الخوف والكراهية، واتضح للشركات أنها بحاجة ماسة إلي أن تصطنع وجهًا إنسانيا تستعيد به محبة الناس ومن ثم اتجهت الحملات الإعلانية لشخصنة الشركة في أعين الجماهير.. وعكست الشركات صورتها في الإعلام باعتبارها كائنات خيرة صاحبة (مسئولية اجتماعية).
ولكن ككل دعاية أمريكية: تمضي الصورة الإعلامية في طريق وتسلك المؤسسة صاحبة الصورة في طريق آخر متناقض مع هذه الصورة الوردية. وظل أثر الشركات في استغلال البشر والإضرار بالمجتمع والبيئة محسوسًا متفاقمًا حتي عام 1934م عندما جاء الرئيس «فرانكلين روزفلت» بسلسلة من القوانين والإجراءات عرفت باسم (العهد الجديد) New Deal ليضع حدًا لهذا الغول المفترس.
والعهد الجديد عبارة عن مجموعة من الإصلاحات والإجراءات التنظيمية المتكاملة استهدفت التغلب علي الكساد الاقتصادي الذي عم في تلك الفترة.. وإعــــادة الحيــــاة الصحية للاقتصاد المريض نتيجة للحريات المفرطة والصلاحيات غير المحدودة التي كانت تمارسها المؤسسات الاقتصادية علي نطاق واسع.
وظل تأثير العهد الجديد ملموسًا حتي انحسرت موجته تمامًا سنة 1980 في عهد الصديقين: رونالد ريجان الأمريكي ومسز تاتشر البريطانية، وبدأت الحكومات الغربية تحذو حذوهما بإطلاق حرية الشركات التي ألزمت الحكومات بالتخلي عن دورها في توجيه الاقتصاد الوطني.. وعدم اللجوء إلي تنظيم الشركات بل فرضت علي الحكومات التوسع في خصخصة القطاع العام، وتخفيض سقف الإنفاق الحكومي، وتقليل التضخم المالي، وبحلول التسعينيات من القرن العشرين تربعت حرية السوق علي عرش الاقتصاد، وأصبحت الليبرالية الجديدة هي إنجيل الاقتصاد العالمي.. وقد دعم سطوة الشركات العملاقة ما حدث من تقدم هائل في تكنولوجيا المواصلات والاتصالات، وأصبحت أكبر خطر يهدد الحكومات، خصوصًا بعد ظهور الشركات متعددة الجنسيات أو عابرة القارات ــ كما يسمونها ــ فلم يعد لها مكان ثابت يمكن تعيينه أو التصويب عليه. لقد أفلت الجِنّي ذو القوة الخارقة من القمقم وحلق في سماء العولمة، وأصبح الكوكب الأرضي كله مجالاً لنشاطه ينزل في أي مكان منه حيث يشاء وينطلق منه منتقلاً إلي بلد آخر متي شاء بلا حدود ولا قيود.
المسئولية الاجتماعية علي المحك:
تزعم الشركات العملاقة أنها قادرة علي تنظيم نفسها بنفسها وليست في حاجة إلي حكومات تنظمها، وتفاخر بمبادراتها الاجتماعية والبيئية وأن لديها أقسامًا وخبراء لتنفيذ ومراقبة برامجها في المسئولية الاجتماعية وانطلقت حملات دعائية كبري في التليفزيونات تهلل وتبارك لظهور فجر عصر جديد أصبح فيه للشركات دور فاعل في رعاية المجتمع والحفاظ علي بيئة نقية وصحية.. فهل لهذا الضجيج من حقيقة؟ وهل يمكن أن يكون لهذا الكلام مصداقية؟
يقول المؤلف: من الناحية القانونية.. يجرّم القانون أي سلوك يناقض تعظيم أرباح حملة الأسهم.. وليس للمديرين أي حق أو سلطة قانونية لاستهداف أي أعمال خيرية.. ولم يجد رجال الإدارة مخرجًا من هذا المأزق إلا بالاعتراف بالحقيقة وهي أنهم بممارسة المسئولية الاجتماعية إنما يسعون بعملهم لتعظيم أرباح الشركة بما يكسبون من دعاية وما يحصلون عليه من تخفيضات ضريبية نظير هذه الأعمال الخيرية.
بذلك تبقي الشركة محتفظة بجوهرها.. كائنًا جشعًا أنانيا فهي شخصية سيكوباتية من طراز مروع.. ويشرح لنا المؤلف هذه الحقيقة في عشرات الأمثلة نكتفي بالإشارة إلي بعضها.
من هذه الأمثلة شركة فايزر Fayzer التي ترسل دواء مجانيا لبعض دول أفريقيا لعلاج مرض التراكوما الذي يتسبب في حالات كثيرة من فقد البصر.. ولكن كما يؤكد المؤلف: لا تخسر الشركة بهذه التبرعات شيئًا وإنما تكسب أضعاف ما تنفق من ناحيتي الدعاية والضرائب كما أشرنا.. فإذا نظرنا إلي الحقيقة من زاوية أخري لرأينا الوجه القبيح لشركات الأدوية العالمية فهذه الشركات تملك أموالاً طائلة ولديها مراكز أبحاث متقدمة ونخبة من العلماء، وتستطيع لو أرادت أن تطور أدوية جديدة لبعض الأمراض القاتلة التي تحصد ملايين البشر كل عام في بلاد العالم الثالث، مثل أمراض السل والملاريا والإيدز.. ولكنها لا تفعل، والسبب كما يقول المؤلف هو أن تكاليف استخدام أدوية جديدة تفوق العائد منها، حيث إن 80% من سكان العالم الذين يعيشون في هذه البلاد الفقيرة يمثلون 20% من سوق الدواء العالمي يخص أفريقيا كلها 1.3%، بينما نجد أن 20% من سكان العالم الغني يعيشون في أوروبا وأمريكا الشمالية واليابان ولكنهم يمثلون 80% من سوق الدواء، ولذلك تطور الشركات لهذه البلاد أدوية لعلاج أمراض الترف مثل الصلع والعقم والعنة. بل إن تطوير أدوية جديدة لعلاج الاضطرابات النفسية لحيواناتهم المنزلية لها أولوية فوق أدوية العالم الفقير.
الشخصية السيكوباتية:
يقول المؤلف: إن الدعاية الواسعة للشركات العملاقة لتحسين صورتها والكلام عن (المسئولية الاجتماعية) كلام في الهواء لا يغير الطبيعة الجوهرية لهذه الشركات في سباقها المحموم لتكديس الثروة وعدم المبالاة بحياة البشر ومعاناتهم. وفي هذا تتجلي الشخصية الحقيقية للشركة فهي كائن سيكوباتي مريض يتسم بكل الخصائص المميزة للشخصية السيكوباتية كما يعرفها علماء النفس.
ويوضح لنا «روبرت هير» أستاذ علم النفس ذو الشهرة العالمية هذه الحقيقة عندما يستعرض قائمة سمات الشخصية السيكوباتية في تطبيقها علي سلوك الشركة فيقول: تتمحور الشركة حول مصالحها الأنانية فقط.. تمامًا كما يفعل الشخص السيكوباتي. وسنجد تماثلاً مذهلاً في جميع السمات السيكوباتية كلما تعمقنا في دراسة سلوك الشركة: الإفراط في تقدير قيمة الذات (نحن الأفضل.. نحن رقم 1)، عدم القدرة علي التقمص العاطفي، أو الشعور بمشاعر الآخرين وآلامهم، اتجاهات مدمرة ضد اجتماعية، عدم القدرة علي الشعور بالندم.. حتي عندما تعبر عن أسفها فإن عبارات الندم تخلو تمامًا من بطانتها الوجدانية فهي مجرد كلمات جوفاء لا تعبر عن ندم جواني حقيقي، محاولة الشركة أن تنتمي إلي الجماهير إنما تسلك سلوك السيكوباتي في محاولة انتمائه إلي الآخرين بطريقة سطحية، فهي تستخدم الكلمات المحببة كنوع من المهارة اللغوية التي يجيدها السيكوباتي (النصاب) عادة.. إنها تستخدم نفس القناع لتخفي حقيقتها الجوانية.
إنرون كنموذج للشخصية السيكوباتية
كانت شركة «إنرون» ــ لعهد قريب ــ من أكبر شركات الطاقة في الولايات المتحدة.. ظل يضرب بها المثل في احتضانها للمسئولية الاجتماعية.. ودأبت كل عام علي تضمين تقاريرها السنوية برامج المسئولية الاجتماعية التي أنجزتها، وتعهدت بالعمل الجاد علي خفض تسرب الغازات الضارة بالبيئة.. وتدعيم الاتفاقات الدولية لوقف تدهور المناخ الكوني، كما تعهدت أن تضع في صلب عملياتها الصناعية قضايا حقوق الإنسان والبيئة والصحة والسلامة والشفافية.. واعتذرت عن تسرب 29 ألف برميل نفط من سفنها علي سواحل أمريكا اللاتينية، ووعدت ألا يتكرر هذا الخطأ بعد ذلك أبدًا.. وعددت المساعدات السخية التي قدمتها لمجتمعات المدن التي تعمل بها.. وأنها خصصت اعتمادات مالية كبيرة لمنظمات أدبية وللمتاحف والمعاهد التعليمية وجماعات المحافظة علي البيئة.. ولأغراض خيرية أخري حول العالم.
وتكرر في تقاريرها القول المأثور: إن قيادة المؤسسة ينبغي أن تضع المثل الأعلي في خدمة المجتمع! كلام وردي جميل ولكن لا صدي له في الواقع العملي، فهذه القيادة المثالية هي نفسها التي أفسدت الشركة وتلاعبت بأسهمها في البورصة ونشرت تقارير مالية زيفتها شركة محاسبات أخري فاسدة.. فأقبل الناس علي شراء الأسهم بأسعار عالية بينما إدارة الشركة علي علم تام بأن أسهم الشركة لم تعد تساوي شيئًا، نهبت قيادات الشركة ملايين الدولارات وتركتها تنهار علي رؤوس حملة الأسهم.
تبرز لنا قصة انهيار شركة إنرون حقيقتين كبيرتين.. أولاهما أن الهوة واسعة بين الصورة الخيرة التي ترسمها الشركات لنفسها بحذق وبين واقعها الإجرامي. والحقيقة الثانية تتمثل في هوس الشركات بحصد الأرباح وولعها بمخالفة القواعد والقوانين.. والتلاعب بالناس.. وهذه كلها خصائص متجذرة في ثقافة الشركات الكبري بلا استثناء.. ولكن الفرق في حالة إنرون أنها أخذت هذه الخصائص إلي مدي أبعد من قدرتها علي الاحتمال والصمود فانتهت بتدمير نفسها.
ربح الشركات لها ومغارمها علي الآخرين:
الشركة باعتبارها كائنًا سيكوباتيا لا يمكنها أن تسلك سلوكًا أخلاقيا أو تكف عن إيذاء الآخرين في سبيل تحقيق مصالحها الأنانية.. فما دامت الشركة تحقق مزيدًا من الأرباح لا يهمها ماذا يخسر الآخرون بسبب نشاطها أو إنتاجها، وقد أصبح لهذا الاتجاه مصطلح متداول في إدارة الشركات Externalization والمعني العملي لهذا المصطلح يجعل من حق الشركة أن تذهب في خفض تكاليف الإنتاج إلي المدي الذي يمكن أن يعود بالضرر علي الآخرين، فهذه ليس مشكلة الشركة وإنما ــ في نظرها ــ هي مشكلة الآخرين.
يوضح المؤلف هذه الحقيقة بمثال بسيط فيقول: الشخص الذي يتحمل اتساخ ملابسه بسبب (الهباب) الذي ينفثه مصنع قريب من بيته أو مكان عمله.. ويتحمل نفقات إضافية لغسيل وكي هذه الملابس المتسخة، بينما يحصل صاحب المصنع أرباحًا إضافية وفرها من عدم اتخاذ إجراءات الوقاية اللازمة: مثل بناء مداخن عالية أو تركيب (فلاتر) لمنع العوادم بدلاً من نفثها في الهواء.. أو نقل المصنع إلي مكان ناءٍ بعيدًا عن المناطق السكنية.
والحقيقة أن تأثير هذا الاتجاه في تحميل الآخرين وزر الشركات له أبعاد مأساوية في حياة البشر، وهو يكشف عن خطر هذه المخلوقات المفترسة التي لا تعبأ بشيء في سبيل تحقيق مزيد من الأرباح وتقليص التكاليف.
من أمثلة المآسي المترتبة علي تقليص تكاليف الإنتاج ما ساقه المؤلف في إطار قضية السيدة باتريشيا أندرسون ضد شركة سيارات جنرال موتورز التي سمحت بوضع خزان وقود السيارة في موضع معرض للانفجار لأي تصادم خفيف مع سيارة أخري، وقد تسبب انفجار السيارة بالفعل في حروق مؤلمة غطت 60% من جسمها وأجسام أربعة من بناتها كن معها في السيارة، واضطر الأطباء لقطع ذراع إحدي بناتها لإنقاذ حياتها.
ونتبين من تقرير الخبراء وتحقيقات المحكمة الحقائق الآتية:
1 ــ أن وضع خزان الوقود بالسيارة قريبًا أكثر مما ينبغي من الصدّام الخلفي للسيارة هو السبب الرئيسي لانفجارها.
2 ــ أن جميع السيارات من هذا الطراز بها نفس هذا العيب.
3 ــ أن مصمم السيارة ــ باستجوابه ــ قرر أنه خير إدارة الشركة بين تصميم أكثر أمانًا بتكلفة أعلي قليلاً، وبين تصميم أقل تكلفة ولكنه أقل أمانًا فاختارت الأقل تكلفة رغم أن الفرق لم يزد علي ستة دولارات فقط.
4 ــ أن الشركة ــ بوعي كامل ــ قامت بتحليل التكلفة والعائد وقدرت قيمة التعويضات المحتملة للضحايا، ثم اتخذت قرارها بناء علي هذا التحليل.
وبناء عليه حكمت المحكمة علي الشركة بدفع تعويضات للسيدة باتريشيا وبناتها بلغت أكثر من مليون دولار.. وضمنت قرارها غياب الوازع الأخلاقي في عملية الإنتاج وعدم مراعاة قدسية حياة البشر. وهنا كان اعتراض الغرفة التجارية علي الحكم لأنه يضرب في الصميم مبدأ (تحليل التكاليف والعوائد) الذي يعتبره رجال الأعمال القاعدة الأساسية للشركات. لم يكن اعتراض رجال الأعمال علي قيمة التعويضات ولكن علي تأسيس حكم علي الوازع الأخلاقي!!
جرائم التكلفة الصناعية في العالم الثالث:
مغامرة مثيرة قام بها باحث اسمه تشارلز كيرنهام كرس حياته للكشف عن المخالفات القانونية والإنسانية للشركات عابرة القارات في العالم الثالث.. وشمل بحثه عددًا من البلاد الآسيوية وأمريكا اللاتينية.. وكان عليه أن يحتال لكي يصل إلي مواقع هذه الشركات ويدخلها فإدارة الشركات متفقة مع السلطات المحلية ترفض الإدلاء بأسماء مصانعها أو عناوينها لأي باحث متطفل.. ولكنه وقع علي كنز ثمين وهو يبحث في أكوام المخلفات الصناعية بجمهورية الدومينيكان حيث عثر علي دفاتر وسجلات بصندوق مغلق تحتوي علي تفاصيل دقيقة لحسابات تكاليف مصنع للقمصان الرجالي.. وتبين له أن خياطة القميص مقسمة إلي 22 عملية صغيرة تستغرق كلها 6 دقائق للقميص وهو ما يساوي (8 سنتات أجرة للعامل) بينما يباع هذا القميص نفسه في الولايات المتحدة بمبلغ 23 دولارًا.
أما حياة العمال من الأطفال والبنات الصغيرات فنموذج حي للبؤس والتعاسة، فقد شاهد كيرنهام كيف تعمل البنات الصغيرات تحت رقابة حراس غلاظ، وكيف يتعرضن للإهانة والضرب علي أبسط هفوة يرتكبنها.. ويخضعن بصفة دورية لاختبارات حمل قسرية، فمن وجدت حاملاً تطرد علي الفور من المصنع.. أما العمل فهو روتيني ممل متكرر، ويتم تحت أنوار مبهرة مدمرة للأعصاب.. وتستغرق دورية العمل اليومية من 12 إلي 14 ساعة.. أماكن العمل مرتفعة الحرارة ولا توجد تهوية أو تكييف.. وبها دورات مياه قليلة العدد.. ومياه الشرب شحيحة تصرف بحساب دقيق لتقليل الحاجة إلي ترك العمل والذهاب إلي دورة المياه.
يقول كيرنهام: عادة ما تعمل الفتاة حتي تبلغ الخامسة والعشرين فتطرد من العمل، لأنها تكون قد استهلكت تمامًا، ولم تعد تصلح للاستخدام. ومن ثم تجلب الشركة محصولاً جديدًا من الفتيات.. وتحصد من عملهن مليارات الدولارات بينما لا يزيد أجر الواحدة منهن علي ثلاثين سنتًا في الساعة. عمالة شبه مجانية تستغل الشركات عابرات القارات فيها ملايين الأطفال الذين يدفعهم الجوع والفقر للعمل في أتعس بيئة للعمل، وقبول أجور لا تسمن ولا تغني من جوع.. إنها ظروف عمل مهينة ــ علي حد قول المؤلف ــ يقصد بها انتزاع آدمية الإنسان منه.. وهي جزء لا يتجزأ من منظومة الشركة: طاحونة تجرف كل شيء لتحطيمه.. ففي قلب كل شركة آلية رهيبة تعمل علي تعظيم أرباحها وترغم الآخرين علي دفع مغارمها من حياتهم وكرامتهم.
شاهد من أهلها:
لقد استيقظت ضمائر بعض رجال الأعمال بعد أن ثبت لهم مدي خطورة الشركات علي حياة الناس والبيئة.. أجري المؤلف مع بعضهم لقاءات تحدثوا فيها عن لحظة يقظتهم.. يقول أحدهم وهو روبرت مونكس: «كانت أول مرة أشعر بأن في الشركات شيئًا خاطئًا عندما كنت مسافرًا في رحلة عمل واستيقظت في جوف الليل علي التهاب حاد في أنفي وعيني ورأيت من النافذة كميات هائلة من رغاوي بيضاء تطفو علي سطح النهر الذي يمر من أمام الفندق، وعلمت في الصباح أن مصنعًا للورق قد اعتاد أن يلقي بهذه النفايات الكيماوية الكريهة الرائحة في مياه النهر كل ليلة.. منذ هذه اللحظة أدركت أن الشركة بتركيبتها الاستغلالية خطر محقق علي المجتمع.. إننا ونحن نتكالب علي الربح نخلق كائنًا مرعبًا سوف يدمرنا جميعًا».
وقصة رجل أعمال آخر ومدير إحدي الشركات الكبري لم يكن يدرك شيئًا عن تأثير عوادم المصانع في تلويث البيئة والقضاء علي الحياة فيها.. حتي تبينت له الحقيقة من خلال قراءاته التي اضطرته بعض الظروف الطارئة للقيام بها.. يقول: كان هذا الكشف بمثابة حربة انغرست في صدري.. ومرت بي لحظات شعور أليم بالذنب تغيرت فيها عقيدتي بل مجري حياتي كله.. كان «راي أندرسون» يعتقد مثل غيره من رجال الأعمال أن الأرض لا نهاية لما في باطنها من مواد خام.. وأنها مستودع لا نهاية لقاعه في استيعاب السموم والنفايات التي نقذفها بها كل لحظة.. ولكنه بدأ يفيق إلي خطورة إلقاء مغارم الشركات علي أكتاف الآخرين.
جنرال إليكتريك:
جميع الشركات الكبري لها سجل حافل في هذا المجال وقد أورد المؤلف عشرات الأمثلة، تطرقنا إلي بعضها، وهذا مثل آخر لشركة جنرال إليكتريك التي بلغت مخالفاتها القانونية أبعادًا كارثية.. فبين سنة 1990 وسنة 2000م ارتكبت هذه الشركة 43 مخالفة كبري.. وصدرت ضدها أحكام محاكم لا حصر لها.. تضمنت هذه المخالفات: تلويثًا رهيبًا للتربة والمياه والأنهار والهواء في مواقع عديدة وبأسلوب نمطي متكرر.. وكذلك دفن نفايات كيماوية سامة.. والتسبب في سقوط طائرات نتيجة أخطاء صناعية جسيمة في أجزاء وقطع غيار قامت بإنتاجها.. وكذب في الإعلان عن ماكينات بها عيوب خطيرة تعلم مسبقًا بوجودها ــ إلي غير ذلك من مخالفات قانونية وقد بلغت الغرامات المالية في بعض القضايا إلي 147 مليون دولار.. ومع ذلك ظلت الشركة (العالمية المشهورة) تكرر نفس المخالفات بعناد وإصرار غريبين.
إن مدير أي شركة ــ فيما يقول روبرت مونكس يسأل نفسه كم تكلفني إطاعة القانون وكم تكلفني مخالفته؟ فإذا رجحت كفة المخالفة علي كفة الطاعة اتخذ قراره بالمخالفة ولا يبالي.. إن المجرمين الحقيقيين يتسترون وراء (الشخصية الاعتبارية) التي منحها القانون للشركات فخلق بذلك مسخًا يفوق خطره خطر دراكولا.
مؤامرة لقلب نظام الحكم في البيت الأبيض:
هذه واقعة موثقة في سجلات تحقيقات الكونجرس الأمريكي، وأُلفت عنها كتب لعل من أهمها كتاب «جولز آرتشر» بعنوان: المؤامرة علي البيت الأبيض صدر سنة 1973. ولكن القصة ترجع إلي سنة 1933 عندما انتخب فرانكلين روزفلت رئيسًا للإدارة الأمريكية وكانت الولايات المتحدة تمر بكساد اقتصادي مروع، ورأي روزفلت أنه لا مخرج من هذا الكساد إلا بشل اليد الخفية التي تلعب في السوق.. وكان يقصد يد الشركات والبنوك الكبري، ومن ثم جاء بما سمي بـ (العهد الجديد) مما ألمحنا إليه سابقًا.. وهو مجموعة من القوانين والإجراءات التنظيمية وهيئات الرقابة، كلها تؤدي مهمة متكاملة تستهدف تقوية سيطرة الحكومة علي البنوك والشركات وتمنح بعض الحقوق العادلة للعمال.. ووصف روزفلت منظومته هذه بأنها منظومة تستهدف منفعة جمهور واسع من المواطنين، بدلاً من المنظومة السابقة التي لم تكن معنية إلا بامتيازات طبقة خاصة من الناس.. دأبت علي ترديد فكرة أن آليات السوق وحدها كافية للخروج من الأزمات الاقتصادية وإعادة التوازن الاقتصادي.
لقد حقق العهد الجديد أهدافه وتيقن كثير من رجال الأعمال أنه كان ضروريا لحماية الرأسمالية من نفسها.. إلا أن فئة أخري من رجال الأعمال وأصحاب البنوك أعماهم الغضب واعتقدوا أن خطة روزفلت من شأنها القضاء علي الرأسمالية الأمريكية، ومن ثم تجمعوا وبدءوا يفكرون في مؤامرة ضد روزفلت للإطاحة به، وإقامة دكتاتورية فاشية بدلاً من النظام الديمقراطي.
في 24 أغسطس 1934 تقدم «جيرالد ماجاير» وهو محارب متقاعد إلي الجنرال المتقاعد «سميدلي دارلنجتون بتلر» ليفاتحه في أمر الانقلاب.. وكان سميدلي بطل حرب مشهورًا في البحرية الأمريكية نال كثيرًا من النياشين وأنواط الشرف.. وكان موضع احترام من الجميع. أفضي إليه «ماجاير» برسالة شفوية من مجموعة من كبار رجال الأعمال يناشدونه بناء جيش من المحاربين القدامي والاستيلاء علي البيت الأبيض، وإعلان نفسه حاكمًا علي البلاد وزعيمًا فاشيا علي غرار هتلر وموسليني.. وأنه سوف يلقي من المجموعة دعمًا بلا حدود.
وتساءل الجنرال في ذهول: ولم دكتاتورية فاشية؟.. وجاءته الإجابة مفصلة علي مراحل خلال جلسات عدة حيث تبين له إعجاب هؤلاء المتآمرين بإنجازات الفاشية في ألمانيا وإيطاليا، وما حققته من ازدهار رأسمالي، فقد استطاع هتلر وموسليني تخفيض الدين العام في بلديهما.. واستطاعا كبح جماح التضخم المالي.. وتخفيض أجور العمال وإخضاع النقابات والاتحادات العمالية.. وأحكما سيطرتهما علي هذا كله بكفاءة عالية. أما روزفلت الديمقراطي ــ في نظرهم ــ فهو خائن لطبقته.. ويحاول بعهده الجديد تدمير الرأسمالية.
كذلك تبين للجنرال بتلر أن شركات أمريكية كبري كانت ضالعة مع هتلر في بناء قوته العسكرية مثل شركة «جنرال موتورز» التي تحولت إلي الصناعات العسكرية سنة 1937 وكانت منتجاتها تحقق له التفوق في كثير من الجبهات الأوروبية. ومثل شركة «آي بي إم» التي ساعدت هتلر بحاسباتها ذات البطاقات المثقبة، وكان خبراؤها الأمريكيون يساعدون في تدريب الألمان وفي تركيب هذه الآلات حتي في معسكرات الإبادة الجماعية لليهود، وكانوا يعلمون الكثير عن الهولوكوست (انظر كتاب «إدوين بلاك: آي بي إم والهولوكوست»)، وكان هتلر يغدق الأموال علي هذه الشركات الأمريكية.
إنه إذن مبدأ الربح حيثما وجد هو ما تتكالب عليه الشركات، ولا يهمها الإطاحة بالمبادئ الأخلاقية والإنسانية، فهي لا تسأل عن ذلك، إنما تسأل فقط هل هذا النظام السياسي يساعد أو يعوق سعيها في تحقيق أهدافها الأنانية؟ ولم تنسحب هذه الشركات ــ عندما انسحبت ــ لدوافع وطنية أو أخلاقية وإنما تجنبًا لمخاطر الحرب عندما اشتد أوارها.
لم يكن غريبًا إذن أن تنشأ في عقول أمثال هؤلاء الرجال الجشعين فكرة التآمر لقلب نظام ديمقراطي وإقامة نظام فاشي في عهد روزفلت.
في أحد لقاءات «ماجاير» مع «بتلر» أخرج من حقيبة معه كومة من الأوراق المالية فئة الألف دولار، ونشرها علي سرير الجنرال في الفندق لتمويل المشروع، فأمره بتلر أن يعيد النقود إلي مكانها لأنه ليس في حاجة إلي مال في تلك المرحلة.. ولكنه طلب منه قائمة بأسماء الرجال المعنيين بمشروع الانقلاب فزوده بأسمائهم.
وكشف «ماجاير» للجنرال بتلر عن خطة المتآمرين: فهم يتوقعون بعد إنشاء الجيش المنشود أن يطلب الجنرال من روزفلت تنصيبه نائبًا للرئيس، فإذا قبل يبدأ الجنرال ممارسة سلطات الرئيس، ويبقي روزفلت مجرد رمز للرئاسة الاسمية، أما إذا رفض التعاون فعلي الجنرال أن يتدخل بجيشه، ويطرد روزفلت من البيت الأبيض ويستولي علي السلطة كما فعل موسليني في ملك إيطاليا. وقدم «ماجاير» ثلاثة ملايين دولار دفعة أولي للبدء في المشروع، ووضع تحت تصرفه في البنك ثلاثمائة مليون دولار أخري لمتابعة المشروع.
كان المتآمرون يعتقدون باختيارهم للجنرال بتلر لتنفيذ خطة الانقلاب أنهم قد وقعوا علي صيد سمين لما كان له من شهرة وجماهيرية، ولم يتبينوا أنهم وقعوا علي الرجل الخطأ إلا بعد فوات الأوان.. فقد تقدم بتلر إلي الكونجرس وأفشي أسرار المؤامرة بكل تفاصيلها وشخصياتها أمام لجنة التحقيقات.
من أهم ما قاله بتلر في شهادته: «إن هؤلاء المتآمرين يمثلون كل ما أكره وأحتكر في بلادي.. فقد تعلمت من دروس الحروب التي خضتها أن هناك حربًا في وطني علي أن أخوضها أولاً وهي محاربة هؤلاء المنافقين.. بعد أن عرفت أن كل هذه الحروب كان وراءها جشع هؤلاء الناس.. وأن جنودي لم يكونوا يحاربون في سبيل مبادئ عليا كما كنا نتصور، وإنما من أجل الشركات الجشعة التي لا تشبع من نهب ثروات الشعوب».
استراتيجية جديدة للإضعاف لا الإجهاز:
تعلمت الشركات درسًا مهمًا من فشل مؤامرة الانقلاب علي روزفلت وبدأت تستخدم تكتيكًا حديثًا أكثر نعومة وأعمق إثراء بهدف إلغاء القوانين والإجراءات التنظيمية التي تقيد حرية الشركات، وتمييع سلطات أجهزة الرقابة الحكومية علي سلوكها.. يعني باختصار: إضعاف الحكومة بدلاً من الإجهاز عليها.
في هذا السياق يحكي لنا المؤلف قصة شركة إنرون في هذا المجال، وكيف كانت تتلاعب بإمدادات الكهرباء في ولاية كاليفورنيا.. وعمليات الإظلام المتعمد للإضاءة في كل الولاية ومحاولة قهر الجماهير والتلاعب بأسعار الكهرباء. حدث كل هذا بينما آلتها الإعلامية تضخ أكاذيب عن كثرة الإجراءات التنظيمية التي تعوق عمل الشركة ورغبتها في الإصلاح. وكانت الاستجابة الفورية من الإدارة الأمريكية متسقة مع هذا الاتجاه حيث أعلن جورج دبليو بوش بإنجليزيته الركيكة: «إذا كانت هناك إجراءات بيئية منعت كاليفورنيا من الحصول علي 100% كهرباء.. فنحن في حاجة إلي التخفيف من هذه الإجراءات». وكان هذا بمثابة رد لجميل الشركة التي أسهمت بملايين الدولارات في حملة انتخابات الرئاسة لصالح بوش، وقام رجل آخر في الكونجرس يردد نغمة الشكر بصوت أعلي فيقول موضحًا للهدف: «إن الذين يؤيدون إجراءات التطرف البيئي ويدفعون بالدولة للتدخل أكثر مما ينبغي، ويعوقون حرية السوق هم الذين يدفعون بنا نحو الكارثة».
لا يجب أن ننسي أن هذا الموقف الأمريكي لم يقتصر أثره علي الولايات المتحدة فقط وإنما امتد إلي البيئة الكونية، فقد رفض بوش الأصغر التوقيع علي اتفاقية دولية لحماية البيئة بتقليل انبعاث الغازات المسببة لتدمير الغلاف الجوي، بزعمه أن هذا التقييد سيعود بالضرر علي الصناعات الأمريكية.. وليذهب العالم إلي الجحيم!
الشركات الكبري لديها عقيدة أن القواعد والإجراءات التنظيمية التي تضعها الحكومات تقلل من أرباحها.. ولذلك فإن وضع استراتيجيات للقضاء علي هذه القواعد والإجراءات بكل الوسائل أمر مشروع. وخلال العقد السابع من القرن العشرين برز بوضوح شديد أن من أكفأ الوسائل التي استخدمتها الشركات (التبرعات) المالية السخية للحملات الانتخابية بهدف التأثير علي العملية السياسية بترجيح كفة مرشح علي مرشح آخر. ويعلق المؤلف علي ذلك بقوله: «في المحصلة النهائية.. سواء عن طريق التبرعات أو الرشاوي الصريحة أو عن طريق جماعات الضغط السياسي أو حملات العلاقات العامة.. فإن الشركات تسعي للتأثير علي العملية الديمقراطية لنفس الأسباب التي استهدفها المتآمرون علي روزفلت في الثلاثينيات «فأولئك حاولوا تدمير النظام الديمقراطي بانقلاب عسكري وهؤلاء يفسدون النظام بالرشوة..».
وقد نظن أن الأموال التي تنفقها الشركات في هذا المجال خسائر عليها ولكن يؤكد لنا وليام نيسكانين أن الشركات لا تخسر شيئًا لأنها تحسب هذا الإنفاق الهائل جزءًا من تكاليف الإنتاج.. فهو استثمار لخلق بيئة سياسية أنسب لمضاعفة أرباحها ومساعدتها علي الاستمرار والازدهار».
يري رجال الأعمال أن لهم دورًا مشروعًا كشركاء مع السلطة في حكم المجتمع.. وأنه ليس للحكومة دور مشروع في السيطرة علي الشركات.. وأن واجب الحكومة أن تترك الشركات تنظم نفسها بنفسها فهي مسئولة اجتماعيا.
الخصخصة والعولمة:
ساد الاعتقاد في القرن العشرين أن الديمقراطية تتطلب حكومات منتخبة تحمي الحقوق الاجتماعية للمواطنين وتوفر لهم احتياجاتهم الأساسية، فالمصالح العامة أعز وأقدس من أن تخضع لشركات مستغلة غير مسئولة ولا هم لها إلي الاسترباح من هذه المصالح فيما يوضح المؤلف: المؤسسات الصحية ومرافق المياه.. وخدمات التنمية الإنسانية كالمدارس والجامعات والمعاهد الثقافية.. والأمن العام كالشرطة والمحاكم والاطفائيات.. والمناطق الطبيعية كالمحميات الطبيعية للنبات والحيوان.. والحدائق العامة.. كل هذه المرافق والخدمات الحيوية اللازمة لحياة الإنسان ونموه وضعتها القوانين في منأي عن قبضة الشركات أن تعبث بها.
ولكن للأسف الشديد أصبحت كل هذه المرافق والخدمات الآن عرضة لزحف الشركات في حربها الإعلامية لتحطيم الحواجز القانونية التي تحيط بهذه المنطقة المحرمة.. وصكّت لهذه الحرب شعارين جديدين هما الخصخصة والعولمة. وبدأت الحكومات تتهاوي أمام زحف «دراكولا»، هذا المسخ الذي خلقته بيديها.. فلم يعد هناك شيء في المجال العام محرمًا أو مقدسًا، بل أصبح كل شيء إما في حالة خصخصة أو في طريقه إلي الخصخصة. العالم إذن يتجه نحو مجتمع جديد يصفه لنا أحد دعاة الخصخصة هو «ملتون فريدمان» بقوله: «في هذا المجتمع لن يبقي في حوزة الحكومة أكثر من 10 إلي 20% من الدخل القومي للإنفاق علي وظائفها الأساسية كالنظام القضائي والقوات المسلحة والتخفيف من حالات الفقر الحادة..» بل إن «وليام نيكانين» يقلص صلاحيات الحكومة ووظائفها بحيث لا يبقي لها سوي القوات العسكرية».. إن مروجي الخصخصة يرون أن كل بوصة مربعة علي هذا الكوكب الأرضي ينبغي أن تكون تحت سيطرة القطاع الخاص.
انتهاك عالم الأطفال وتدمير صحتهم:
ابتدعت الشركات في إعلاناتها استراتيجية جديدة للحصول علي نقود الآباء عن طريق التلاعب بعقول الأطفال.. لا فيما يتعلق بالسلع الخاصة بالأطفال فحسب بل في السلع المنتجة للكبار أيضًا.. في هذه الاستراتيجية الجديدة تستخدم الشركات أحدث وسائل العلم والتكنولوجيا، وتسخر طائفة من علماء النفس لبحث أكفأ الأساليب الإعلانية في التأثير علي الطفل.. فإذا تعلقت حاجته بمنتج معين يلح في طلبه من أبويه فلا يفلتان من إلحاحه حتي يتحقق له طلبه.
وقد وجدت الدراسات أن إلحاح الأطفال له قوة سحرية في التأثير علي الأبوين.. وهم مادة سهلة للتلاعب فلديهم قابلية عالية للاستهواء.. ويتقبلون الرسائل الإعلامية كأنها حقائق.. كما أنهم في نظر الشركات المستغلة هم زبائن المستقبل تحت التدريب. وللدكتورة «سوزان لين» أستاذة الطب النفسي بجامعة هارفارد دراسة مهمة في هذا المجال، فقد تبين لها أن الطفل الأمريكي يشاهد ــ في المتوسط ــ ثلاثين ألف إعلان تجاري في السنة.. وهي إعلانات آسرة تتسلط علي الطفل وتحاصر خياله.. وفي هذا المناخ يقذف الإعلان إليه بأنواع من المأكولات المشبعة بالدهون والسكريات الضارة بصحة الأطفال حتي أصبح من المستحيل علي الآباء ضبط غذاء أطفالهم...
وتتفق مع هذه النتائج دراسات أخري لطبيب أطفال أسترالي هو «فيرتي نيونهام» مع فريق من الباحثين وجدوا أن التدفق الإعلاني الرهيب علي الأطفال يؤثر سلبًا علي صحتهم واختياراتهم في وقت مبكر من حياتهم ويضعهم في دائرة الخطر الصحي.. وتؤكد دراسات أخري منشورة في مجلات طبية عالمية ظهور زيادة هائلة من مرضي السمنة والسكري عند الأطفال وهما مرضان خطيران يلازمان الطفل بعد ذلك طوال حياته.
وفي دراسة أخري أثبت الباحثون أن خطر إعلانات الأطفال لا يقتصر علي صحته البدنية فقط، وإنما يمتد إلي قدراتهم العقلية والتخيلية.. خصوصًا ما يتعلق منها بلعب الأطفال الجاهزة التي تثير إعجاب الأطفال وتذهل عقولهم الصغيرة وتسيطر عليهم، بينما يحتاج الطفل ــ فيما يري الخبراء ــ إلي ألعاب من نوع آخر يقومون هم بتفكيكها وتركيبها وفق أشكال يتخيلونها هم.. وهذا يعطيهم الشعور بالسيادة علي الأشياء، ويساعدهم علي الإبداع.
ثورة كوتشابامبا هي الحل:
في بحثه عن حلول لمواجهة الخطر لا يري المؤلف أي أمل في الحكومات أن تنهض لمقاومة طغيان الشركات، ولا أن تتراجع الشركات عن غيها من تلقاء نفسها، ولم يبق إلا الشعوب والناس العاديون أن ينظموا أنفسهم في حركات شعبية لمواجهة الخطر بأنفسهم.. وقد بدأت بالفعل مجموعات كبيرة تتحرك في قلب أوروبا وأمريكا ضد الخصخصة والعولمة وضد تلوث البيئة وضد استغلال الفقراء في العالم الثالث. يقول المؤلف: هذا ما ينبغي أن نعمل علي تقويته بالوعي والكتابة والإعلام والمظاهرات.. واقتراح الحلول البديلة الضغط علي الحكومات بكل وسيلة ممكنة، والمجال في هذا واسع فسيح.. ويضرب لنا مثلاً بواقعة ذات دلالة علي إمكانية نجاح الحركات الشعبية.. حدثت في منطقة بوسط بوليفيا تسمي «كوتشابامبا».
بطل هذه الواقعة هو «أوسكار أوليفيرا» أحد قادة العمال.. تزعم تمردًا شعبيا ضد خصخصة مرفق مياه الشرب، الذي اضطرت إليه الحكومة تحت ضغوط البنك الدولي، واشترته شركة «بكتل» الأمريكية التي سيطرت علي كل مصادر المياه البديلة وكان الأهالي يعتمدون عليها، وذلك استنادًا إلي قوانين جديدة أجبرت الحكومة علي إصدارها وتنفيذها بقوة الشرطة. فلما أصبحت الشركة هي المصدر الوحيد لمياه الشرب رفعت أسعار المياه ثلاث مرات عما كانت عليه من قبل، وهنا تفجرت ثورة شعبية أحسن أوسكار أوليفيرا تنظيمها وقيادتها وجذبت كل يوم مزيدًا من الثوار من كل فئات المجتمع وحدثت مصادمات عنيفة استخدمت فيها الشرطة والجيش الرصاص الحي فقتلت ستة من الناس وفقد بعض الشباب أطرافهم وأصبح بعضهم مشلولين بإصابات في العمود الفقري ولكن عشرات الألوف من الثوار أجبروا الشركة علي الفرار من المنطقة وتسلم الثوار المرفق لإعادة تنظيمه وإدارته..
يقول المؤلف: لا مناص من مجابهة قوة الشركات الزاحفة بقوي الشعب المنظمة.. لإحياء قيم مناهضة لقيم هذه الشركات.. إنها تحاول قصر هويتنا علي كوننا أنانيين وفرديين ولدينا رغبات استهلاكية مستحكمة، ولكننا نرفض أن تكون هذه كل هويتنا فنحن أيضًا نشعر بروابط إنسانية عميقة والتزامات أخلاقية نحو بعضنا البعض، ونشترك في مصير واحد وآمال في عالم أفضل.. وكلنا يشعر أن هناك أشياء عزيزة علينا ومهمة لا يمكن أن تكون موضع استغلال من أحد.. إننا بناة حضارة ولسنا مجرد منتجين ومستهلكين كما تصورنا الشركات المستغلة.
تحـــــولت الشركات المساهمة التي
اســــــتطاعتالحكومة الإنجليزية إلغاءها
سنة 1720 ــ إلي كائن شرس يسيطر
علي الحكومات والمجتمعــات
تتمحور الشركة
حول مصالحها الأنانية فقط..
تمامًا كما يفعل الشـــخص السيكوباتي.
وسنجد تماثلاً بينهما في جميع
السمات السيكوباتية
في قلب كل شركة آلية رهيبة
تعمل علي تعظيم أرباحها وترغـــم
الآخرين علي دفع مغارمهـــا من
حياتهم وكرامتهم
شركات أمريكية كبري
كانت ضالعة مع هتلر في
بناء قوته العسكرية مثل شركة
«جنرال موتورز» التي تحولت
إلي الصناعات العسكرية
سنة 1937