لا يوجد من يدفع الثمن ..لماذا لا يتكامل العرب اقتصاديا؟
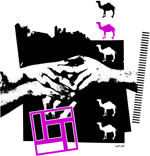
رغم كثرة الحديث عن التعاون الاقتصادي العربي، أو التكامل أو حتي الاندماج، فلا تزال العلاقات الاقتصادية العربية/العربية محدودة. فمنذ إنشاء جامعة الدول العربية في 1945 ثم المجلس الاقتصادي والاجتماعي في 1953 ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية 1957، ورغم العديد من الاتفاقات الاقتصادية العربية، فلا تزال التجارة البينية العربية أقل من 10% من حجم التجارة الخارجية للدول العربية في حين أنها تبلغ حوالي 40% في مجموعة الدول الآسيوية وأكثر من 20% في دول أمريكا اللاتينية، فضلاً عن السوق الأوروبية التي تزيد فيها التجارة البينية علي 60%. ولا يقتصر الأمر علي ضآلة حجم التجارة العربية البينية، بل إن معدل نموها شهد في التسعينيات تناقصاً وليس تزايداً. ونأمل أن يكون في توقيع اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة في 1998 والبدء في تنفيذها ما يغير من هذه الأوضاع والتوجهات.
ويعترف معظم الاقتصاديين بوجود عدد من العقبات المادية أو المؤسسية التي أعاقت في وقت أو آخر من نمو التجارة العربية علي النحو المأمول به. وهناك تداخل في كثير من الأحيان بين العقبات المادية والمؤسسية. فمن بين العقبات المادية نحو نمو التجارة ضعف شبكة المواصلات من طرق وخطوط ملاحية وخدمات مرتبطة، ومع ذلك فكثيراً ما تزيد الإجراءات المتبعة من أسباب عرقلة انسياب التجارة بين الدول. فإذا كانت شبكة الطرق بين مختلف الدول غير كافية علي عكس الوضع مثلاً بالنسبة للدول الأوروبية فإن إجراءات الحدود والتخليص الجمركي كثيراً ما تزيد الأمور تعقيداً مما يؤدي إلي رفع تكلفة النقل. أضف إلي ذلك أن هناك علاقة تبادلية يختلط فيها السبب بالنتيجة في العلاقة بين نقص حجم التجارة العربية البينية ونقص خطوط الملاحة البحرية بين مختلف المواني العربية. فنتيجة لصغر حجم التجارة العربية البينية بين الدول العربية لا توجد خطوط ملاحية كافية ودائمة وبالتالي ترتفع تكلفة النقل بين هذه الدول. وبالمقابل، فإنه نظراً لعدم توافر الخدمات الملاحية بشكل كاف، فإن فرصاً للتجارة تضيع. وهكذا، تتداخل الأسباب مع النتائج، وتصبح هذه العقبة سبباً لنقص التجارة ونتيجة في نفس الوقت.
وبالإضافة إلي هذه العقبات المادية، كانت هناك عقبات سياسية ومؤسسية، وخاصة في الستينيات عندما انقسم العالم العربي إلي معسكرين، معسكر الدول «التقدمية» أو الاشتراكية من ناحية، ومعسكر الدول «الرجعية» أو الرأسمالية من ناحية أخري. وبصرف النظر عن دقة الأوصاف، فقد عكس هذا الانقسام السياسي والأيديولوجي قطيعة كبيرة في العلاقات الاقتصادية لأسباب سياسية وأيديولوجية. ورغم أن هذه الأوضاع قد تلاشت إلي بعيد منذ السبعينيات، فإن آثار هذه الفترة مازالت قائمة في الأذهان بدرجات متفاوتة. فمن ناحية مازالت هناك «ذكريات» الشكوك والريبة المتبادلة، وهناك أيضاً مؤسسات نشأت في ظل هذه الأوضاع، وبالتالي استمرت في ممارسات قديمة حيث يصعب تغييرها بين ليلة وضحاها.
علي أن الأمر لابد أن يكون أعمق مما تقدم فهذه العقبات أو معظمها، لا تعدو أن تكون أموراً وقتية ما تلبث أن تزول. وبالفعل فإن العديد من هذه العقبات مادية ومؤسسية قد تلاشت أو تضاءلت إلي حد بعيد خلال الثلاثين سنة الماضية، ولم تزل حال التكامل الاقتصادي العربي علي ما هي عليه. فمنذ السبعينيات وقد بدأ التناقض الأيديولوجي في الزوال، واتجهت معظم الدول العربية إلي الأخذ بشكل أو آخر من أشكال اقتصاد السوق والدعوة إليه. كذلك فإن الاستثمارات في البنية الأساسية، من حيث شبكة المواصلات وسعة المواني وحجم خطوط الطيران قد زادت بدرجة كبيرة. ومع ذلك فإن ذلك لم ينعكس في شكل تغيير ملحوظ في حجم العلاقات التجارية العربية، ومن ثم فلابد من البحث عن أسباب أكثر عمقاً وراء هذه الظاهرة.
ويمكن القول بأن تضاؤل النتائج المتحققة في ميدان التعاون الاقتصادي العربي يطرح قضية منطقية بالنسبة لمدي عقلانية العمل العربي. وهل يعمل «النظام العربي» لمصلحته أم ضد مصلحته؟ السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: لماذا لم يتحقق التكامل الاقتصادي العربي في الواقع رغم كثرة الحديث عنه؟
هل هناك منطق اقتصادي؟:
إذا كان صحيحاً أن مزيداً من الاندماج الاقتصادي الإقليمي (العربي) نافع ومفيد، فإن السؤال يطرح نفسه، لماذا إذن لم يتحقق هذا التقارب الاقتصادي العربي، ولماذا ظل شعاراً للمناسبات أكثر منه حقيقة علي أرض الواقع؟ هل معني ذلك انعدام في الرشادة الاقتصادية، بحيث يتجاهل المسئولون العرب مصالحهم ويتخذون مسارات ضد هذه المصلحة؟ ويتضمن طرح الموضوع بهذا الشكل عدة أمور يصعب التوفيق بينها؛ وهي أن:
1 -هناك اتفاق علي أن مزيداً من التعاون والاندماج الاقتصادي يؤدي إلي تحقيق مصلحة اقتصادية جوهرية للدول العربية.
2 -رغم الاعتراف بهذه المصلحة، فإن هذا التعاون لا يتحقق علي أرض الواقع بدرجة كافية رغم التغني بمزايا الوحدة عبر نصف قرن من الزمان.
3 -أخيراً يصعب أن ننسب إلي المسئولين في الدول العربية عدم رشادة السلوك أو انعدام المنطق في سياساتهم. فالمسئولون السياسيون في معظم الدول العربية رغم ما قد يبدو أحياناً يتصرفون عادة بدرجة كبيرة من الرشادة والدهاء السياسي ولا ينقصهم المنطق السليم في الاستقرار والاستمرار السياسي. فكيف تفوتهم هذه الحنكة السياسية عندما يتعلق الأمر بالمصالح الاقتصادية؟
هذه هي المعضلة. كيف يمكن التوفيق بين هذه المقولات الثلاث المشار إليها، كيف تكون رشيداً ومنطقياً في سلوكك السياسي بشكل عام، ولا تعمل في نفس الوقت علي تحقيق أوضاع تزيد من «المنفعة الاقتصادية العامة»؟
لعلّ الإجابة علي هذا التناقض تكمن في تحديد معني «المنفعة الاقتصادية العامة»، ومدي ما تتضمنه من تكاليف بالنسبة لمتّخذ القرار، الأمر الذي يتطلب التذكير بفكرة «السلعة العامة».
التكامل الاقتصادي «سلعة عامة»:
يعرف الاقتصاديون «السلعة» بأنها كل شيء نافع من ناحية وأن توفيرها يتطلب تكلفة أو تضحية من ناحية أخري. فالسلعة يجب أن تكون نافعة ولكنها أيضاً ليست مجانية بل إن لها تكلفة. فليس كل شيء نافع سلعة. فالهواء وهو أنفع الأشياء لا يعتبر سلعة لأنه لا يكلف شيئاً (لم يعد الأمر كذلك بشكل مطلق. فنظراً لأننا نعيش في عالم ملوث، فقد أصبح الحصول علي الهواء النقي مكلفاً من حيث الذهاب إلي الأماكن النظيفة والتي لم تفسدها أشكال التلوث البيئي). والأصل أن العلاقة بين المنفعة والتكلفة تحدد ما ينتج من سلع، فما دامت المنافع تزيد علي التكاليف، فإن المجتمعات تتجه إلي توفير هذه السلع حيث إن ما تحققه من ورائها من منافع يزيد علي ما تتحمله من تكاليف وأعباء. وتقوم عادة السوق بتوفير هذه السلع. ولكن هذا الأمر لا يتحقق دائماً في الواقع حيث إن هناك من السلع التي لا شك في منافعها والتي تزيد فيها هذه المنافع علي تكاليفها، ورغم ذلك فإنها لا تتوافر تلقائياً في السوق. وهذا يقتضي التفرقة بين ما يعرف ب«السلع الخاصة» private goods و«السلع العامة» public goods.
ويشترك النوعان في أن توفيرهما يتطلب تكاليف وأعباء، وبالتالي فهي ليست منحاً مجانية، ولكنهما يختلفان في نوع المنفعة التي تترتب عليهما ومدي إمكان الاستئثار أو شيوع الانتفاع بها. أما التكاليف فلابد أن يتحملها أفراد أو مؤسسات بعينها. وما لم يكن هؤلاء الأفراد والمؤسسات علي استعداد لتحمل تكاليف إنتاج السلعة، فإنه لا يمكن توفيرها مهما بلغت منافعها. ولذلك فإن توفير أي سلعة إنما هو رهن بمدي توافر الاستعداد لتحمل تكاليف وأعباء توفيرها، فإذا لم يوجد هذا الاستعداد فلن تنتج هذه السلع وإن طال الحديث عن أهميتها. وبطبيعة الأحوال فإن الاستعداد الاختياري لتحمل تكاليف وأعباء توفير السلعة، إنما يرتبط بمدي تقدير المنفعة العائدة من هذه السلعة ومقارنة هذه المنفعة بالتكاليف المطلوبة. والعبرة هنا بالمنفعة والتكلفة العائدة لمن يتحمل التكلفة، أما ما يعود علي الغير فإنه لا يدخل في الحساب. ولذلك فمن الضروري أن تكون هذه المنافع قابلة للاستئثار وليست شائعة. وهنا نجد أن السلع تختلف فيما بينها من حيث شيوع أو استئثار المنافع المترتبة عليها.وهذا هو أساس التفرقة بين «السلع الخاصة» و«السلع العامة». فالأولي تعرف مبدأ الاستئثارprinciple of exclusion بمعني أن المستخدم للسلعة يفيد منها بشكل عام وحده دون مشاركة الآخرين، وبالتالي فإنه يكون عادة علي استعداد لتحمل تكاليفها. وتنجح السوق بالتالي في توفيرها. أما «السلع العامة» فإن منافعها تكون عادة شائعة، فمتي أديت لفرد فإن الغير يمكن أن يفيد منها بلا تكلفة، الأمر المعروف في أدبيات الاقتصاد ب«الراكب المجاني» free rider. ومن هنا فإن السلع العامة تثير عادة مشكلة كبري في توفيرها. فهي ليست أقل أهمية أو فائدة من «السلع الخاصة»، بل قد تكون أكثر أهمية، مثل توفير الأمن والاستقرار والعدالة ونظام نقدي مستقر ومرافق عامة ومع ذلك فالغالب ألا يتقدم أحد، اختياراً، لتحمل تكاليف توفيرها. فلا يوجد أي تناقض أو عدم رشادة في التأكيد علي أهمية ومنفعة سلعة أو خدمة من ناحية وعدم إمكان توفيرها من ناحية أخري. فالاعتراف بمنفعة السلعة أو الخدمة لا يعني، منطقياً قبول تحمل أعباء وتكاليف إنتاجها وتوفيرها. فقد تتركز التكاليف والأعباء علي فئة في حين أن المنفعة تكون شائعة وموزعة علي آخرين. وبالتالي نكون بصدد سلعة أو خدمة عامة بحيث لا يكون أحد مستعداً لتحمل أعباء توفيرها، ولذلك فإنه من المتفق عليه أن السلع والخدمات العامة لا يمكن توفيرها اختياراً رغم أهميتها وأنه لابد من تدخل سلطة عليا أو الوصول إلي اتفاق بين المتعاملين علي كيفية توفيرها وتوزيع أعباء إنتاجها عليهم.
وفيما يخص الموضوع الذي نحن بصدده، فإننا نعتقد أن التعاون أو الاندماج الاقتصادي العربي هو نوع من السلعة أو الخدمة العامة الإقليمية التي تعود بالنفع علي الجميع، ولكن هذا النفع شائع متي تحقق أفاد منه الجميع ولا يمكن حرمان أحد منه. وعندما نتحدث عن الجميع فإننا نشير إلي الأفراد والمشروعات سواء منها القائمة أو المحتملة الإنشاء، وسواء منها الوطني أو الأجنبي فالجميع يشمل كافة الوحدات الاقتصادية في الحاضر والمستقبل التي تتعامل مع الاقتصاد. وبالمقابل فإن توفير هذه السلعة أو الخدمة ليس أمراً مجانياً، بل تترتب عليه أعباء وتكاليف. وإذا كانت منافع التعاون الاقتصادي تعود علي الجميع بهذا المعني، فإن القرار في شأنها هو من شأن السلطات السياسية التي تضع القيود علي سيادتها ومدي الحواجز بين الصناعات القائمة بها وبين الخارج. ففي حالة التعاون الاقتصادي العربي، فإننا نجد أنفسنا بصدد وضع لدول مستقلة عليها أن تقدر المنافع والأعباء التي تعود عليها كدول أو نظم سياسية من هذا التعاون وما يترتب علي ذلك من تأثير علي نشاطها الاقتصادي. فإذا كانت الأعباء التي تفرض علي هذه الدول كنظم سياسية أو قطاعات اقتصادية تجاوز المنافع التي تعود عليها مباشرة فلا أمل في أن تقبل مثل هذا التعاون وذلك بصرف النظر عما يعود بالفائدة علي الآخرين مهما بلغ عددهم ومهما كانت هذه المنافع. ولا يتناقض هذا السلوك إطلاقاً مع الرشادة الاقتصادية، بل إنه يعتبر انصياعاً لها. فليست الرشادة هي في المقارنة بين المنافع الإجمالية والتكاليف الإجمالية، وإنما هي في المقارنة بين المنافع العائدة إلي متخذ القرار السياسي بالتكامل الاقتصادي والتكاليف التي يتحملها، أما ماعدا ذلك فإنه لا يعدو أن يكون من العناصر الخارجية externalities التي لا تدخل في حسابه. فنقطة البدء في مناقشة قضية التعاون الاقتصادي العربي، هي أنها قضية تعني بالعلاقة بين قرارات سياسية تتخذ لإزالة العقبات أمام التكامل الاقتصادي وأن المنطق وراءها هو مدي ما يتحقق لمتخذي هذه القرارات من منافع أو تكاليف تعود عليها مباشرة.
أعباء وتكاليف كبيرة:
بدأ الحديث عن التعاون الاقتصادي العربي كما ذكرنا منذ إنشاء الجامعة العربية، بعد الحرب العالمية الثانية، وارتفعت النبرة خلال فترة الخمسينيات والستينيات فيما عرف بحركة القومية العربية. وهكذا فإن الدعوة إلي التعاون أو الاندماج الاقتصادي ارتبطت في الأساس بدعوة سياسية قومية. وتستند هذه الدعوة إلي وحدة الأمة العربية، وإن الحدود السياسية إنما هي حدود اصطناعية فرضها الاستعمار ومن ثم وجب إزالتها. فالأقطار العربية القائمة ينبغي أن تزول لتتحقق الوحدة العربية السياسية. وهكذا جاءت الدعوة للتعاون الاقتصادي العربي في بدايتها وتحمل في طياتها بشكل غير صريح ولكنه غير خفي تساؤلات عن مدي شرعية الحدود السياسية ووجود الأقطار العربية نفسها. وقد عاصر هذه الفترة شيوع نظم حكم عربية ذات طابع عسكري وانقلابي مما ساعد علي تأكيد هذه الهواجس والمخاوف. وهكذا بدا كما لو كان ثمن التعاون الاقتصادي العربي هو تهديد نظم الحكم والأوضاع الاقتصادية القائمة في العديد من البلدان. وهي تكلفة عالية لا يقبل أحد بتحملها حتي وإن كانت المنافع المقابلة هي اتساع السوق وزيادة الازدهار الاقتصادي، وهي منافع شائعة تعود علي الجميع بلا تحديد. أما التكلفة السياسية علي النُظُم القُطرية فهي مركزة وكبيرة في نفس الوقت. ومع بروز الثروة النفطية، وخاصة في السبعينيات، ظهر تناقض أكبر بين الثروة المالية الجديدة وبين دعوة الوحدة العربية أو الثورة العربية. فالدعوة للتعاون الاقتصادي العربي بدت في ذلك الوقت بشكل ما كما لو كانت دعوة للمشاركة في هذه الثروة الجديدة الوافدة، الأمر الذي أوجد حساسية لدي قطاعات واسعة من مواطني الدول الخليجية. فشعار نفط «العرب للعرب» يمكن أن يتضمن مفاهيم كثيرة بعضها يشير إلي اقتسام هذه الثروة بين العرب. وبذلك فقد تضمنت الدعوة إلي التعاون الاقتصادي العربي منذ البداية تهديداً للنظم السياسية القائمة وللهياكل الاقتصادية السائدة. وهو ما يمثل ثمناً باهظاً لعديد من النظم السياسية، وبالتالي وجب منطقياً عدم الحماس له، أو الرغبة في اقتسام الثروة النفطية بعد أن خف خطر التهديد السياسي. وهو أمر لا يدعو بدوره إلي الحماس لدي النخب في الدول النفطية. وهكذا غلب علي الدعوة للتعاون العربي تلميحات بتهديدات خفية علي المستوي السياسي أو الاقتصادي.
ولا يقتصر الثمن السياسي للتعاون الاقتصادي العربي آنذاك فيما بدا من تهديدات لاستقرار العديد من النظم السياسية، بل إنه حتي مع اختفاء مثل هذا التهديد وخاصة بعد أن بدأت مرحلة التعايش بين النظم المختلفة بعد حرب 67، فإن هذا التعاون كان يتضمن بشكل ما تقييداً لسلطات النظم السياسية القائمة في العديد من البلدان العربية. فالحاكم في معظم البلدان العربية ويستوي في ذلك الدول النفطية وغير النفطية آنذاك وأيا كان لقبه ملكاً أو أميراً، أو رئيساً، أو قائداً فهو عادة حاكم مطلق لا تكاد تحد إرادته أية قيود، وهو يتمتع بهذه السلطات تجاه أبناء شعبه حيث لا سلطة تعارضه. ولاشك أن فتح الأبواب لأبناء الدول الشقيقة ووراء كل منهم حكومته من شأنه أن يقيد من سلطات الحاكم إزاء بعض الضغوط من الدول الشقيقة حماية لمصالح أبنائها، الأمر الذي يتضمن تضييقاً لسلطات الحاكم.
وإذا كانت الدعوة إلي التكامل الاقتصادي العربي قد صاحبها وخاصة في بدايتها مخاوف من تحمل تكاليف وأعباء سياسية للنظم السياسية القائمة فإن الأمر لم يخل أيضاً من تكاليف وأعباء اقتصادية يمكن أن تتحملها بعض القطاعات الصناعية التي تتمتع بحماية لا ترغب في التخلي عنها.
فالصناعة في معظم الدول العربية قد قامت علي أساس إحلال الواردات ووجود سوق محلية تحظي بحماية جمركية عالية نسبياً. ولذلك فإن هذه الصناعات تري بشكل عام في تحرير التجارة مع العالم الخارجي أو من خلال تعاون إقليمي إضعافًا لمركزها التنافسي في الداخل، وبالتالي مهددة لأرباحها. وهكذا فإن مثل هذه الصناعات تعبر عادة عن نوع من المقاومة لأية إجراءات يترتب عليها إضعاف ما تتمتع به من حماية للسوق المحلية. ومن هنا موقفها المناوئ في كثير من الأحيان لإجراءات التعاون الاقتصادي الإقليمي فيما يتضمنه من تخفيف أو إزالة ما تتمتع به هذه الصناعات من مركز متميز في أسواقها المحلية.
والتعاون الاقتصادي الإقليمي، شأنه شأن كل قرار اقتصادي، يؤدي إلي منافع وأضرار، عوائد وأعباء. فهناك المستفيدون منه. كما أن هناك أيضاً المتضررين، والعبرة في النهاية هي بالمقارنة بين حجم ووزن المنافع من ناحية وحجم ووزن الأضرار من ناحية أخري. ومع ذلك فإن الأمر ليس متعلقاً فقط بالحجم المطلق لكل منهما، بل كثيراً ما يتعلق بالصوت العالي Voice. فهناك بعض المصالح القادرة علي التعبير عن نفسها بقوة رغم أنها قد لا تكون كبيرة، في حين أن مصالح أخري كبيرة قد لا تنجح في التعبير عن نفسها بنفس القوة رغم أهميتها. ويعتبر المثال السابق عن المقارنة بين موقف بعض الصناعات الوطنية من تحرير التجارة بالمقارنة وموقف جمهور المستهلكين منه نموذجاً واضحاً للعلاقة بين الصوت العالي وحجم المصالح.
فإذا كان تحرير التجارة يضعف من الوضع التنافسي أو الاحتكاري لعدد من الصناعات المحلية، فإنه يوفر للمستهلكين في نفس الوقت فائدة كبيرة في إتاحة السلع بأسعار أقل وربما بنوعية أفضل. وهكذا نجد تقابلا بين ما قد يلحق بعض الصناعات من خسارة، وبين ما قد يحققه المستهلكون من كسب كنتيجة لتحرير التجارة أو للتعاون الاقتصادي الإقليمي. وقد يكون الكسب المتحقق أكبر من الخسارة الواقعة، ولكن الغالب هو أن صوت الصناعيين يكون عادة أعلي وأقوي من صوت المستهلكين. ولذلك أسباب. ونشير في هذا الصدد إلي أمرين. الأمر الأول التفرقة بين الخسارة «المحققة» «realized loss» وبين الكسب «الضائع» «foregone benefit » فهنا نقارن بين شركة تحقق بالفعل خسارة أو نقصاً في الأرباح، وبذلك فإنها تتحدث عن أشياء تحققت بالفعل بالمقارنة بالماضي، وهي أمور يمكن قياسها، وبالتالي فإن الشعور بها يكون عادة قوياً. أما الكسب المحتمل، أو المتوقع، فهو إشارة إلي «أمل» لم يتحقق في أي وقت في الماضي، وإنما هو تطلع إلي المستقبل. ولذلك فإن المطالبة به تكون أقل حدة مما هو الحال في الدفاع عن الخسائر المتحققة. هذا عن الأمر الأول الذي يؤدي إلي رفع أصوات المقاومة (الصناعات المحلية) أعلي من أصوات التأييد (جمهور المستهلكين). فبعض أصحاب الصناعات وهم يعارضون التعاون يتحدثون عن خسائر حقيقية تلحقهم، أما المستهلكون فيندر أن يدافعوا عن الأمل في مكاسب يمكن تحقيقها.
أما الأمر الثاني فهو يرجع إلي تركز أو تفرق أصحاب المطالبات. فبالنسبة لأصوات الصناعة المطالبة بإبقاء الحماية فإن عدد الصناعات يكون عادة محدوداً ولذلك فإن حجم الخسارة التي تلحق بكل منهم تكون عادة كبيرة تبرر المطالبة بالصوت العالي فضلاً عن أنهم لقلة عددهم يكونون عادة قادرين علي تنظيم مقاومتهم بشكل فعال. أما أصحاب المصلحة في خفض أسعار السلع المتاحة وتحسين نوعيتها فإنهم من جمهور المستهلكين، وهم أعداد كبيرة متفرقة كل منهم قد يحقق كسباً صغيراً. ورغم أن مجموع المكاسب قد يكون كبيراً بل وكبيراً جداً، فإن أصوات المطالبة بالتحرير قد لا تكون عالية. فهم لتفرقهم وتشتتهم غير قادرين علي التنظيم وبالتالي الفاعلية. وهم أيضاً بالنظر إلي تشتتهم فإن النفع العائد علي كل منهم يكون عادة قليلاً لا يبرر التعبئة الكبيرة لهذه القضية. ومن هنا كثيراً ما نجد أن مصالح الأقليات تجد آذانًا مصغية أكثر من مصالح الأغلبية، لأن الأغلبية بطبيعتها كسولة وغير منظّمة. وينطبق هذا المنطق بالنسبة للمقاومين والمؤيدين لإجراءات تحرير التجارة. فالمقاومة تأتي عادة من أقلية نشطة ذات مصالح كبيرة ومركزة، في حين أن التأييد لا يظهر بنفس القوة لعدم تركز هذه المصالح وتشتتها بين أعداد كبيرة قليلة الاهتمام.
وما تقدم لا يحول دون الاعتراف بأن هناك اعتراضات تمثل معارضة مشروعة للحماية من المنافسة «غير العادلة» من الدول الشقيقة. فمنتجات بعض الدول تتمتع بميزة تنافسية تجاه أسعار الدول الأخري الشقيقة المنافسة ليس بسبب كفاءة إنتاجية وإنما بسبب مزايا تتمتع بها في دولها في شكل إعانات صريحة أو ضمنية. وقد اعترفت اتفاقات منظمة التجارة العالمية بحق الدول المنضمة إلي الاتفاقية باتخاذ إجراءات لمواجهة «الإغراق» أو الإعانات لحماية الصناعة المحلية في مواجهة منافسة الدول الأخري. ولا شك أن نوعاً من هذه الإجراءات لابد أن يراعي في تحرير التجارة ضمن أشكال التعاون الاقتصادي العربي. ولذلك فقد يكون من الواقعية الاعتراف بمشروعية جزء من هذه المخاطر التي تتعرض لها بعض القطاعات من جراء فتح الأبواب بين الدول العربية، والعمل علي وضع آلية «لتعويضها» عن هذه المخاطر.
ومن هنا فقد يكون من المناسب أن تتضمن برامج التكامل الاقتصادي الاتفاق علي تخصيص ميزانية وموارد مالية مناسبة لتعويض الأطراف المتضررة من زيادة حجم التبادل التجاري العربي، والعمل في نفس الوقت علي الإزالة التدريجية لأسباب هذه الأضرار. وقد عملت السوق الأوروبية منذ البداية علي الاعتراف بأن بعض القطاعات وخاصة في الزراعة في بعض الدول مثل فرنسا يمكن أن تضار أكثر من غيرها من مزيد من التكامل الاقتصادي الأوروبي، فكفلت اتفاقات التعاون الاقتصادي الأوروبي توفير آلية لتعويض هذه القطاعات. ومن هنا ينبغي النظر إلي التكامل الاقتصادي العربي باعتباره مشروعاً اقتصادياً له منافع كما أن له تكاليف، وهذه وتلك لها نتائج مالية يجب أن تتحملها الدول. فالتكامل الاقتصادي العربي، مثل أي مشروع مهم ولكنه ليس هبة بلا تكلفة، حتي وإن كانت فوائده أكبر.
أمر منطقي تماماً:
إذا كان التحليل السابق صحيحاً، فإن معني ذلك أن التعاون الاقتصادي العربي لم يتحقق في الواقع رغم ما بدا من منافعه لأن هناك أسباباً منطقية تبرر تجاهل هذه المنافع الاقتصادية حيث إن هناك تكاليف وأعباء أكثر أهمية وخطورة من هذه المنافع بالنسبة لمتخذي القرار، وهو عادة قرار ذو طابع سياسي حيث يتعلق بعلاقة الدولة بالخارج ومدي حدود سلطاتها ومزاياها وسيادتها.
يتصل بذلك إن منطق التعاون الاقتصادي الإقليمي لا يزدهر إلا في إطار من الديمقراطية. فالنظم الديمقراطية ليست بطبيعتها عدائية أو تآمرية، فضلاً عن أنها بتداول السلطة، فإنها لا تسمح بقيام السلطة المطلقة للحكومات والتي تقاوم أية مشاركة في هذه السلطة، سواء من الداخل أو من الخارج. وقد يكون من المفيد هنا أن نتذكر أن من أسباب نجاح التعاون الاقتصادي الأوروبي، هو أن القائمين علي إنشاء السوق الأوروبية المشتركة قد عمدوا منذ البداية في اتفاقية روما بإنشاء السوق عام 1957 علي التأكيد علي أن المشاركة في عضوية هذه السوق سوف يقتصر فقط علي الدول الأوروبية التي تمارس الديمقراطية وتشترك في المبادئ والقيم العامة لاحترام حقوق الإنسان. فمع شيوع الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان تتضاءل إلي حد بعيد المزايا السياسية للاستئثار بالحكم والسيطرة علي جميع المقررات السياسية والاقتصادية للبلاد.
يتطلب العلاج إذن الاعتراف بهذه الأمور وإيجاد آلية لمعالجة هذه المطالب المشروعة. وقد يكون من المفيد في هذا الصدد ألا تقتصر جهود العمل علي التكامل الاقتصادي العربي علي المطالبة بإزالة الحواجز، وإنما الاعتراف بأن التعاون أو التكامل الاقتصادي العربي لا يعدو أن يكون مشروعاً له تكلفة كما أن له منافع، وبالتالي ضرورة توفير «ميزانية عربية» لهذا المشروع، لتعويض المتضررين من هذا المشروع. وبدون الاعتراف بهذه التكلفة ومحاولة تعويضهم عنها، فسنظل نتكلم عن مزايا التعاون الاقتصادي في المنتديات والمؤتمرات، ولن يمنع ذلك المتضررين منها من العمل علي وقفها في هدوء وبلا جلبة والله أعلم.
للاستزادة:
الاقتصاد العربى فى عصر العولمة
مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية
حازم الببلاوى
ابو ظبى 2003
التجارة البينية العربية أقل من 10% من حجم التجارة الخارجية للدول العربية في حين أنها تبلغ حوالي 40% في مجموعة الدول الآسيوية وأكثر من 20% في دول أمريكا اللاتينية، فضلاً عن السوق الأوروبية التي تزيد فيها التجارة البينية علي 60%
إذا كان صحيحاً أن مزيداً من الاندماج الاقتصادي الإقليمي (العربي) نافع ومفيد، فإن السؤال يطرح نفسه، لماذا إذن لم يتحقق هذا التقارب الاقتصادي العربي، ولماذا ظل شعاراً للمناسبات أكثر منه حقيقة علي أرض الواقع؟